




 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
| النبض العام يختص باخبار المنتدى و القرارات الادارية و المواضيع التفاعلية والمسابقات و الطرح العام |
 آخر 10 مشاركات
آخر 10 مشاركات
|
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 |
|
تميراوي فضي
رطب لسانك بذكر الله
|
عائض القرني ,
يقول أبو الطيب المتنبي عن الدنيا: وَهيَ مَعشوقَةٌ عَلى الغَدرِ لا تَحفَظُ عَهداً وَلا تُتَمِّمُ وَصلاً كل دمعٍ يسيل منها عليها وبفك اليدين عنها تخلى وملخص البيتين: أن الناس جميعاً يعشقون الدنيا ويموتون في حبّها ولا تصدّق من يسبّها فإنما يفعل ذلك لأنه عجز عن نيلها كما يسبُّ الثعلب العنب إذا حيل بينه وبين العنب، فهو يقول: إن الدنيا يعشقها كل الناس على الرغم من كثرة غدرها بعاشقيها فكم لها من قتيل فلا يدوم بينها وبين خلانها وداد والدليل الفناء الواقع بهم والمصائب النازلة والكوارث الحالة، فكلما أنس صاحب دنيا بدنياه نُغّصت لذّته بفراق أو مرض أو مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله أو أصحابه، ثم يقول في البيت الثاني: لا تصدّق من يبكي من مصائب الدنيا فإنما يبكي تلهفاً عليها وحسرةً على فقدها، وأصلاً الإنسان لا يترك الدنيا ولا يفارقها إلا غصباً عنه وهو لا يزال يتمسك بها حتى تُفك يديه من الدنيا كما تفك يدي الطفل من اللعبة، والبيت الثاني عجب منه الإمام الشوكاني كثيراً وقال عن المتنبي عند هذا البيت: فلا إله إلا الله ما أدق نظره وأعمق فكره وهكذا فليكن الشعر، والمقصود أن الحملات التي تسمعها من الناس في سبّ الدنيا غالبها من أناس حُرموا منها أصلاً ولم يصلوا إلى مقصودهم فأصبحوا ينتقمون بالسبّ والشّتم ولو أُتيحت لهم الفرصة لانهالوا على الدنيا لثماً وضماً، فكم من خطيبٍ أو زاهدٍ أو وجيهٍ أو شاعرٍ حيل بينه وبين نصيبه من الدنيا فقام يشتم الدنيا وزخرفها وزينتها ويحذّر منها وينفّر الناس عنها فلما تمكّن من بعض مقصوده من مالٍ أو منصبٍ أقبل بقضّه وقضيضه على هذا النصيب وانكشف سرّه وعُرفت طبيعته، وغالب المنفّرين من الدنيا إنما فعلوا ذلك لأنه حيل بينهم وبين ما يشتهون فانتقموا من أهل الدنيا بالسبّ والشتم والتحقير وأخذوا يرددون (ومَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى) وهذا صحيح لكنه كلام وُظّف في غير محلّه، ولهذا تجد من حرص على المنصب ثم حيل بينهما أخذ يردد: الحمد الله الذي عافانا وسلّمنا من هذه المسؤولية والأمانة والتّبعة، وإن حصل أن تولّى المنصب قال: هذا بفضل دعاء الوالدة والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإن عُزل من منصبه رددّ: الحمدالله الذي أراحنا وكم كنتُ أتمنى هذه الساعة لأتفرّغ لنفسي وأهلي، إذاً فهي حِيَل البشر النفسية التي توظّف حسب الحالة، فلا تنخدع بالدموع الجارية من عيون الكثير وهم يحذّرون من جمع الحطام والتهالك على المال والحرص على المناصب فهذه الدموع غالبها شوقٌ وحنينٌ وأسف لما فاتهم من نصيبهم وما فقدوه من أمنياتهم، والتّصوف الدخيل على الإسلام هو الذي فرّغ الحياة من معناها ودعا إلى الفرار إلى الكهوف والمغارات وترك الطيّبات والتقاعس عن عمار الأرض وبناء الحياة والله تعالى قد ذمّ هذا المسلك فقال: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ)، وقال تعالى: (قلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)، فاغترّ بهذه الدعوة دعوة التّصوف المخالف للكتاب والسّنة كثيرٌ من المسلمين فهجروا العمل والإنتاج والجد والإبداع والمثابرة إلى البطالة والعطالة والنوم والكسل وسمّوها زهداً وورعاً من باب الحِيل النفسية والجهل بمقاصد الإسلام الذي دعا أتباعه إلى الجمع بين الحسنيين قال تعالى: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)، وقال: (ولا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ)، أليس الصحابة هم أعرف الناس بأسرار التشريع ومقاصد الملّة ومع ذلك فهموا أن الدّين لعمار الروح والعقل والبدن والدنيا والآخرة ففتحوا الأقاليم وشيّدوا الحصون وأسّسوا الجامعات ورفعوا المساجد وبنوا القناطر وقدّموا أروع حضارة للإنسانية وهذه آثارهم تشهد بذلك في الزيتونة والقيروان وقرطبة وأشبيليا والحمراء والزهراء وغيرها ولم يغتروا بخطب الكسالى ودموع التماسيح التي يذرفها من ضعف فهمه للشريعة ويطالب الناس أن يلزموا منازلهم ويتركوا العمل بحجة قرب الموت ودنو الآخرة، وهذا الذي نهى عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بل أدّب بعصاه شباباً لزموا المسجد وأغلقوا على أنفسهم وتركوا العمل واعتمدوا على جيرانهم في إطعامهم فضربهم وقال: أطلبوا الرّزق فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وأبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجراً يهبط الأسواق ويبيع ويشتري وينفق ويتصدّق ويعتق الرقاب ويكرم الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق، وعثمان بن عفان كان تاجراً كبيراً اشترى للمسلمين بئر رؤمة من اليهود وجعلها وقفاً وجهّز جيش تبوك وحده، وعبدالرحمن بن عوف كان من أكبر الأثرياء تصدّق بقافلة عظيمة على فقراء المسلمين، فمن أين أتتنا الثقافة التي تدعونا لإهمال الحياة وتركها لغير المسلمين ليعمروا الجسور ويشيّدوا المدن ويقيموا الأساطيل وينتجوا حاملات الطائرات ويصنّعوا السفن والبارجات ويحتلّوا خيرات الأرض ويطوِّقوا البحار والمحيطات ويبقى المسلمون عالة عليهم همّهم الاستهلاك فقط والشراء ويصرفوا ما بقي من أوقاتهم في سمر طويل، وحديث ثقيل، وسهر وبيل، فسبّب لهم هذا الفراغ القاتل بطالةً وأوهاماً ووساوس وأمراضاً نفسيّة، لأن الصحة مع العمل ،والعافية مع الإنتاج ،والقوّة مع الإبداع ،والطموح والأمل، والتفاؤل مع النجاح، فهيا نعود للفهم الصحيح لديننا ونترك الأحاديث الموضوعة والقصص المختلقة التي وفدت إلينا من عبّاد جهلة ليسوا بعلماء وقد حشا حجّة الإسلام الغزالي إحياءه بأحاديث من هذا النوع حتى إنه يدعوك في الكتاب للزوم المساجد والصحراء والاكتفاء بكسرة خبز كل يوم ولبس قطعة قماش تستر البدن فحسب، وقد عمل هو بهذا فترةً من الزمن وفي آخر حياته رجع إلى دين الفطرة وابتنى بيتاً وأخذ يقرأ صحيح البخاري حتى مات وهو على صدره، قال تعالى: (ِفطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكنيّ أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس مني». |
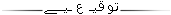

|
|
|
#2 |
|
المستشارة والقآئمه بشؤون العنصر النسآئي
|
بآرك الله فيك وفي طرحك القيم
تقديري |
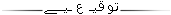
اللهم صل وسلم على نبينا محمد♡

|
|
|
#3 |
|
تميراوي عريق
|
يعطيك العاافيه اخوي وبارك الله فيك
تحياتي لك |
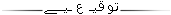
_
[flash=http://im38.gulfup.com/Tf0Yw.swf]WIDTH=500 HEIGHT=230[/flash] 
|
|
|
#4 |
|
المراقب العام
|
قال يحيى بن معاذ :الدنيا خراب وأخرب منها قلب من يعمرها .والآخرة دار عمران وأعمر منها قلب من يطلبها . اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا شكرا بحجم السماء لطرحك الطيب |

|
|
|
#5 |
|
تميراوي الماسي
|
الله يجزاك خير اخوي
|
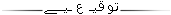
.

|
|
|
#6 |
|
،
|
.بارك الله فيك على طرحك..
|
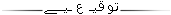
عام مختلف رحم الله خير سلف ووفق الله خير خلف

|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 |
 |
 |