




 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
| النبض العام يختص باخبار المنتدى و القرارات الادارية و المواضيع التفاعلية والمسابقات و الطرح العام |
 آخر 10 مشاركات
آخر 10 مشاركات
|
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 |
|
تميراوي
|
النهايات للمؤلف :عبد الرحمن منيف إنه القحط.. مرة أخرى! وفي مواسم القحط تتغير الحياة والأشياء, وحتى البشر يتغيرون, وطباعهم تتغير, تتولد في النفوس أحزان تبدو غامضة أول الأمر, لكن لحظات الغضب, التي كثيرًا ما تتكرر, تفجّرها بسرعة, تجعلها معادية, جموحًا, ويمكن أن تأخذ أشكالاً لا حصر لها. أما إذا مرَّت الغيوم عالية سريعة, فحينئذ ترتفع الوجوه إلى أعلى وقد امتلأت بنظرات الحقد والشتائم والتحدِّي! وحين يجيء القحط لا يترك بيتًا دون أن يدخله, ولا يترك إنسانًا إلاَّ ويُخلّف في قلبه أو في جسده أثرًا. وإذا كان المسنّون قد تعودوا, منذ فترة طويلة, لفرط ما مرَّ بهم من أيام قاسية, على سنوات المُحْل وعضّة الجوع, وكانت المخاوف تملأ قلوبهم حين يفكّرون فيها, فالكثيرون غيرهم لا يقدرون على مواجهتها بالتصميم نفسه, لأن الكميات القليلة من الحبوب التي توضع جانبًا, بإصرار قوي أول الأمر, لتكون زادًا في أيام الجوع لا تلبث أن تتسرّب أو تختفي, كما يتسرّب ماء النبع أو كما يجفّ المجرى. وتبدأ بعد ذلك محاولات البحث المضني عن خبز اليوم, وخلال هذا البحث تتراكم الأحزان والمخاوف لتصبح شبحًا مرعبًا تظهر آثاره في وجوه الصغار, وفي سهوم الرجال وشتائمهم, وفي الدموع الصغيرة التي تتساقط من عيون النسوة دون أسباب واضحة! إنَّه القحط مرة أخرى. وها هو ذا يسوق أمامه أشياء لا حصر لها, ولا يعرف أحد كيف تتجمع هذه الأشياء وكيف تأتي. فالفلاحون الذين كانوا يحملون سلال البيض وينزلون بها إلى أطراف المدينة, ويتجرأون بعض الأحيان ويصلون إلى وسط الأسواق المليئة بالبشر, والرعاة الذين كانوا يأخذون أجر سنة كاملة بضعة خراف, وكانوا يسوقونها في بداية فصل الربيع, ومعها الحملان الصغيرة, وكانوا يضعونها على صدورهم لأنها ولدت لتوّها, لكي يبيعوها في المدينة, ثم أولئك الباعة الماكرون الذين يحملون على دوابهم العنب والتين والتفاح, ويحملون موازينهم البدائية ومعها قطع الحجارة المصقولة التي تعوّدوا استعمالها أوزانًا, ويبالغون أول الأمر في الأسعار التي يطلبونها إن كل هؤلاء إذا جاءوا في مواسم القحط يجيئون بهيئات مختلفة شديدة الغرابة: كانت ملابسهم ممزقة وغريبة الألوان, وعيونهم مليئة بالحزن والخوف, أمَّا أصواتهم القوية الصاخبة فكانت تنزلق إلى الداخل, وبدلاً عنها تخرج من الصدور أصوات غير واضحة, حتى إنهم كانوا يضطرون إلى إعادة ما يقولون بضع مرات, بناء على الأسئلة الفظة التي يوجّهها لهم أصحاب الدكاكين في المدينة, والذين لم يكونوا ينظرون إلى وجوه هؤلاء الناس قدر ما ينظرون إلى الأيدي أو إلى تلك الصرر الصغيرة المربوطة بإحكام في أطراف الملابس التي يضعونها على أجسادهم أو على رؤوسهم. كان هؤلاء إذا جاءوا في مثل هذه السنين لا يبيعون البيض والفاكهة والزيتون والخراف, وإنما يحاولون شراء أقصى ما تسمح به نقودهم القليلة من الدقيق والسكر. حتى الرعاة الذين كانوا شديدي النزق ويبالغون في المقابل الذي يطالبون به ثمنًا للخراف, وكانوا يفضّلون العودة مرة أخرى ومعهم دوابهم, دون شعور بالأسف لأنهم لم يبيعوا ولم يشتروا حتى هؤلاء يتحولون في مثل هذه السنة إلى رجال متردّدين متوسّلين, لأنهم يريدون التخلص من الدواب الضعيفة المسنّة, إذ أصبحوا يخافون خوفًا حقيقيًّا أن تموت بين لحظة وأخرى من الجوع والعطش. أما الباعة الذين تعوّدوا المجيء في كل المواسم, حاملين من كل موسم ثماره, وفي بعض الأحيان للتجول والفرجة, فلم يعُد أحد يراهم يحملون شيئًا في هذه المواسم, وكأنَّهم مجموعة من القنافذ تكورت وهرّبت أشياءها إلى باطن الأرض! لو اقتصر الأمر على هذه المظاهر لما أثار استغرابًا, لأنَّ العلاقة بين المدينة وما يحيط بها هي من القوة والاستمرار بحيث لا يمكن لأحد أن يميّز بسرعة التغير المفاجئ الذي أخذ يتكون, لكن مع تلك المظاهر كانت أشياء أخرى كثيرة تحصل. فالتجار الذين تعوّدوا على تقديم القروض الصغيرة للفلاحين, واستيفائها أضعافًا مضاعفة في المواسم, اتخذوا موقفًا, بدا, أوّل الأمر, مليئًا بالشروط والتعنت, ثم ما لبثوا أن امتنعوا تمامًا, وافتعلوا لذلك أسبابًا وخصومات. أما الذين استمروا في تقديم بعض المساعدات, فقد رفضوا أن يكون سدادها في المواسم القادمة, وأصرّوا على شروط جديدة. أصرُّوا على أن تسجّل أقسام كبيرة من الأراضي التي يمتلكها الفلاحون بأسمائهم وأسماء أبنائهم, وفي محاولة لإثبات حسن النية قالوا الكلمات التي يقولها الدائنون دائمًا: (الدنيا حياة وموت, والإنسان لا يضمن نفسه في اليوم الذي يعيش فيه, فكيف يضمن حياة أولاده الصغار بعد موته?). كانوا لا يكتفون بذلك, كانوا يضيفون: (وكما قال الله عزَّ وجل في كتابه الكريم: إذا تداينتم بدَيْن إلى أجل مسمًّى فاكتبوه ولْيكتُبْ بينكم كاتبٌ بالعدل والفلاحون الذين قابلوا إصرار هؤلاء الدائنين بإصرار أقوى, ورفضوا تسجيل الأراضي, أول الأمر, اضطر الكثير منهم إلى استخراج الحليّ الذهبية والفضيَّة القديمة, والتي جمعت خلال فترات طويلة سابقة, وقدّموها عوضًا من الطحين والسكر وبعض أمتار من الخام. وفي وقت آخر وافق بعضهم على التنازل وقدّم الأراضي والبساتين التي طلبها الدائنون. ومع كل صفقة جديدة كانت أثمان الأرض في القرى تتراجع, وكان التجار يزدادون تصلبًا ولا يوافقون إلاَّ بشروطهم, وبعد أن تتم جميع الإجراءات! يتبع،،،، |

|
|
|
#2 |
|
تميراوي
|
ومع القحط تأتي أشياء أخرى أيضًا: تأتي الأمراض الغامضة, وتعقبها الوفيات. كان الكبار يموتون من الحزن, والصغار تنتفخ بطونهم وتصيبهم الصفراء ثم يتساقطون. وإذا كان الناس قد تعوّدوا على الموت, ولم يعد يخيفهم كما كان الأمر في أوقات أخرى, برغم أنه يتسبب كل الأوقات في تفجير آلاف الأحزان والأحقاد القديمة, فإنَّ حالة أقرب إلى الانتظار اليائس كانت تحوم فوق كل بيت وتسبح في دم كل مخلوق. حتى الدواب في حواكير البيوت, أو في أطراف البساتين, كانت تسيطر عليها حالة من العصبية واليأس.
وفي هذي السنين, ومع الجوع والموت, تأتي أفواج لا حصر لها من الطيور. ومثلما كانت الغيوم الخفيفة العالية تمرّ مسرعة, كذلك كانت الطيور. فقد كانت أفواجها تعبر في كل الأوقات, حتى في الليل العميق, عالية صائتة, وكأنَّها ذاهبة إلى الموت أو إلى مجهول لا تعرف متى أو أين سيكون. كان الناس ينظرون إلى الطيور نظرة مليئة بالحزن والأسى. تمنوا لو كانت قريبة, أو لو تتوقف قليلاً, لعلهم يظفرون بعددٍ منها يعوّضهم عن الجوع الذي يهدّهم, لكن الطيور تواصل طيرانها المتعب لعلّها تصل إلى مكان ما. والناس لا يتوقفون عن النظر والحسرة, ويتوقعون شيئًا ما, لكن هذا الشيء لا يحصل أبدًا, لأن أسراب الكركي والوز البري, وعشرات الأسراب من الطيور الأخرى واصلت رحلتها المجهدة دون توقّف. أما أسراب القطا والكدري فقد بدأت تظهر بين فترة وأخرى. والفلاحون الذين تعلموا أن هذا النوع من الطيور لا يترك أماكنه الصحراوية, ويقترب من المناطق المزروعة, إلاَّ إذا عضّه الجوع وأضناه العطش. ولم تعد واحات الصحراء أو الخوابي المتناثرة في أماكن عديدة تحوي قطرة ماء, فقد لاحظوا أن هذه الطيور بدأت تتخلى عن الحذر والخوف, أول الأمر, مدفوعة بغريزة البقاء, فتندفع إلى أي مكان لعلها تلتقط بضع حبات أو قطرات من الماء. إنَّها المأساة نفسها تتكرّر مرة أخرى أمام عيون الفلاحين, وهم قد تعوّدوا الصبر والانتظار, وتعوّدوا أكثر من ذلك أن يبدوا التشاؤم والتحفظ, وكانوا يردّدون إذا سئلوا عن المواسم والزراعة: (المواسم لا تعني الأمطار التي تأتي فقط, وإنما أمور أخرى كثيرة). فإذا حصلت لجاجة في السؤال كانوا يختصرون كل شيء بالكلمات التالية: (المواسم تعني ما يقسمه الله وما يتركه الطير), لأنهم في أعماقهم يخافون كل شيء, يخافون انحباس المطر في الشهور التي يجب أن يسقط فيها, أما إذا جاء مبكرًا ونما الزرع وارتفع شبرًا أو شبرين عن الأرض, فكانوا يخافون أن يأتي مطر غزير بعد ذلك الانقطاع, وعندها تغرق الأرض وتنمو الأعشاب الطفيلية ويفسد أو يقلّ الموسم. فإذا جاء المطر هيّنًا متفرقًا, وفي الأوقات التي يجب أن يأتي فيها, فإنَّ الخوف يظل حتى الأيام الأخيرة من أيار, حين تشتد الحرارة فجأة وتحرق كل شيء, فتخيب الآمال وتتراجع الوعود التي أعطاها الرجال للنساء بأثواب جديدة, وللفتيان الذين تجاوزوا سن البلوغ وأصبحوا يطمحون إلى الزواج إن جاءت المواسم الجديدة بالخير. إن هذه الوعود تتراجع يومًا بعد آخر لأن (الشوبة) جاءت وقضت على كل شيء! إنَّ أحدًا لا يحب أن يتذكر أيام القحط. أما إذا جاءت قاسية جارفة, وإذا تكرر مجيئها سنة بعد أخرى, فالكثيرون يفضّلون الموت أو القتل ثم الرحيل على هذا الانتظار القاسي, وآخرون يندفعون إلى حالة من القسوة والانتقام لا يتصورها أحد فيهم, بل ويستغربها هؤلاء الناس أنفسهم في غير هذه الأوقات, وفي غير هذه الظروف. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينتقم من الغيوم أو ممّن يرسلها, فلا بدَّ أن تكون هناك ضحايا من نوع آخر. فالأزواج الذين أبدوا من السماحة الشيء الكثير, ولم يتعودوا الشتيمة أو الضرب, كانوا مستعدين لأن يغيّروا هذه العادات بسهولة, ودون شعور بالذنب. كانوا لا يتردّدون في أن يضربوا ويصرخوا لأتفه الأسباب. والذين كانوا يبدون المرح ويظهرون التفاؤل, يتحولون فجأة إلى رجال قساة بوجوههم وتصرفاتهم. وحتى أولئك الذين كانوا شديدي الإيمان ويَعدّون كل ما تأتي به السماء امتحانًا للإنسان, لا يلبثون أن يصبحوا ضحايا وأكثر الناس شتيمة وتجديفًا, حتى ليستغرب مَن عرفهم من قبل كيف كان هؤلاء الناس يخزنون في صدورهم هذا المقدار الهائل من الشتائم والأفكار الخاطئة المحرمة! هكذا كان القسم الأكبر من الناس في تلك السنة القاسية الطويلة. وإذا كان لكل قرية ولكل مدينة في هذا العالم ملامحها وطريقتها في الحياة, ولها أسماؤها ومقابرها, وإذا كان لكل قرية ومدينة مخاتيرها ومجانينها, ولها نهرها أو نبع الماء الذي تستقي منه, وفيها مواسم الأعراس بعد الحصاد, فقد كان للطيبة أيضًا حياتها وطريقتها في المعاش, وكان لها مقبرتها وأعراسها, وكان في الطيبة مجانينها أيضًا. لكن هؤلاء المجانين لا يظهرون دائمًا ولا يتذكرهم الناس في كل الأوقات, وإن كان لهم حضورهم وجنونهم الخاص, بحيث كانوا كبارًا وأقوياء في أوقات معينة, وكانوا حمقى وشديدي الغرابة في أوقات أخرى. وكان للطيبة دائمًا أعراسها وأحزانها. كانت الأعراس, في أغلب الأحيان, بعد الحصاد, وكانت الأحزان حين ينقطع المطر وتمحل الأرض. وإذا كانت الأعراس تعني بعض الناس, ولبعض الوقت, فإنَّ الأحزان, وفي سنوات المحل, تعني جميع الناس, وتمتد فترة طويلة. يتبع،،،، |

|
|
|
#3 |
|
تميراوي
|
ومع القحط تأتي أشياء أخرى أيضًا: تأتي الأمراض الغامضة, وتعقبها الوفيات. كان الكبار يموتون من الحزن, والصغار تنتفخ بطونهم وتصيبهم الصفراء ثم يتساقطون. وإذا كان الناس قد تعوّدوا على الموت, ولم يعد يخيفهم كما كان الأمر في أوقات أخرى, برغم أنه يتسبب كل الأوقات في تفجير آلاف الأحزان والأحقاد القديمة, فإنَّ حالة أقرب إلى الانتظار اليائس كانت تحوم فوق كل بيت وتسبح في دم كل مخلوق. حتى الدواب في حواكير البيوت, أو في أطراف البساتين, كانت تسيطر عليها حالة من العصبية واليأس.
وفي هذي السنين, ومع الجوع والموت, تأتي أفواج لا حصر لها من الطيور. ومثلما كانت الغيوم الخفيفة العالية تمرّ مسرعة, كذلك كانت الطيور. فقد كانت أفواجها تعبر في كل الأوقات, حتى في الليل العميق, عالية صائتة, وكأنَّها ذاهبة إلى الموت أو إلى مجهول لا تعرف متى أو أين سيكون. كان الناس ينظرون إلى الطيور نظرة مليئة بالحزن والأسى. تمنوا لو كانت قريبة, أو لو تتوقف قليلاً, لعلهم يظفرون بعددٍ منها يعوّضهم عن الجوع الذي يهدّهم, لكن الطيور تواصل طيرانها المتعب لعلّها تصل إلى مكان ما. والناس لا يتوقفون عن النظر والحسرة, ويتوقعون شيئًا ما, لكن هذا الشيء لا يحصل أبدًا, لأن أسراب الكركي والوز البري, وعشرات الأسراب من الطيور الأخرى واصلت رحلتها المجهدة دون توقّف. أما أسراب القطا والكدري فقد بدأت تظهر بين فترة وأخرى. والفلاحون الذين تعلموا أن هذا النوع من الطيور لا يترك أماكنه الصحراوية, ويقترب من المناطق المزروعة, إلاَّ إذا عضّه الجوع وأضناه العطش. ولم تعد واحات الصحراء أو الخوابي المتناثرة في أماكن عديدة تحوي قطرة ماء, فقد لاحظوا أن هذه الطيور بدأت تتخلى عن الحذر والخوف, أول الأمر, مدفوعة بغريزة البقاء, فتندفع إلى أي مكان لعلها تلتقط بضع حبات أو قطرات من الماء. إنَّها المأساة نفسها تتكرّر مرة أخرى أمام عيون الفلاحين, وهم قد تعوّدوا الصبر والانتظار, وتعوّدوا أكثر من ذلك أن يبدوا التشاؤم والتحفظ, وكانوا يردّدون إذا سئلوا عن المواسم والزراعة: (المواسم لا تعني الأمطار التي تأتي فقط, وإنما أمور أخرى كثيرة). فإذا حصلت لجاجة في السؤال كانوا يختصرون كل شيء بالكلمات التالية: (المواسم تعني ما يقسمه الله وما يتركه الطير), لأنهم في أعماقهم يخافون كل شيء, يخافون انحباس المطر في الشهور التي يجب أن يسقط فيها, أما إذا جاء مبكرًا ونما الزرع وارتفع شبرًا أو شبرين عن الأرض, فكانوا يخافون أن يأتي مطر غزير بعد ذلك الانقطاع, وعندها تغرق الأرض وتنمو الأعشاب الطفيلية ويفسد أو يقلّ الموسم. فإذا جاء المطر هيّنًا متفرقًا, وفي الأوقات التي يجب أن يأتي فيها, فإنَّ الخوف يظل حتى الأيام الأخيرة من أيار, حين تشتد الحرارة فجأة وتحرق كل شيء, فتخيب الآمال وتتراجع الوعود التي أعطاها الرجال للنساء بأثواب جديدة, وللفتيان الذين تجاوزوا سن البلوغ وأصبحوا يطمحون إلى الزواج إن جاءت المواسم الجديدة بالخير. إن هذه الوعود تتراجع يومًا بعد آخر لأن (الشوبة) جاءت وقضت على كل شيء! إنَّ أحدًا لا يحب أن يتذكر أيام القحط. أما إذا جاءت قاسية جارفة, وإذا تكرر مجيئها سنة بعد أخرى, فالكثيرون يفضّلون الموت أو القتل ثم الرحيل على هذا الانتظار القاسي, وآخرون يندفعون إلى حالة من القسوة والانتقام لا يتصورها أحد فيهم, بل ويستغربها هؤلاء الناس أنفسهم في غير هذه الأوقات, وفي غير هذه الظروف. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينتقم من الغيوم أو ممّن يرسلها, فلا بدَّ أن تكون هناك ضحايا من نوع آخر. فالأزواج الذين أبدوا من السماحة الشيء الكثير, ولم يتعودوا الشتيمة أو الضرب, كانوا مستعدين لأن يغيّروا هذه العادات بسهولة, ودون شعور بالذنب. كانوا لا يتردّدون في أن يضربوا ويصرخوا لأتفه الأسباب. والذين كانوا يبدون المرح ويظهرون التفاؤل, يتحولون فجأة إلى رجال قساة بوجوههم وتصرفاتهم. وحتى أولئك الذين كانوا شديدي الإيمان ويَعدّون كل ما تأتي به السماء امتحانًا للإنسان, لا يلبثون أن يصبحوا ضحايا وأكثر الناس شتيمة وتجديفًا, حتى ليستغرب مَن عرفهم من قبل كيف كان هؤلاء الناس يخزنون في صدورهم هذا المقدار الهائل من الشتائم والأفكار الخاطئة المحرمة! هكذا كان القسم الأكبر من الناس في تلك السنة القاسية الطويلة. وإذا كان لكل قرية ولكل مدينة في هذا العالم ملامحها وطريقتها في الحياة, ولها أسماؤها ومقابرها, وإذا كان لكل قرية ومدينة مخاتيرها ومجانينها, ولها نهرها أو نبع الماء الذي تستقي منه, وفيها مواسم الأعراس بعد الحصاد, فقد كان للطيبة أيضًا حياتها وطريقتها في المعاش, وكان لها مقبرتها وأعراسها, وكان في الطيبة مجانينها أيضًا. لكن هؤلاء المجانين لا يظهرون دائمًا ولا يتذكرهم الناس في كل الأوقات, وإن كان لهم حضورهم وجنونهم الخاص, بحيث كانوا كبارًا وأقوياء في أوقات معينة, وكانوا حمقى وشديدي الغرابة في أوقات أخرى. وكان للطيبة دائمًا أعراسها وأحزانها. كانت الأعراس, في أغلب الأحيان, بعد الحصاد, وكانت الأحزان حين ينقطع المطر وتمحل الأرض. وإذا كانت الأعراس تعني بعض الناس, ولبعض الوقت, فإنَّ الأحزان, وفي سنوات المحل, تعني جميع الناس, وتمتد فترة طويلة. يتبع،،،، |

|
|
|
#4 |
|
تميراوي فعال
|
مشكور اخوي على الموضوع الرائع
تقبل تحياتي |

|
|
|
#5 |
|
تميراوي
|
الطيبة مثل أي مكان في الدنيا, لها أشياؤها التي تفخر بها. قد لا تبدو هذه الأشياء خطيرة, أو ذات أهمية بالنسبة لأماكن أخرى, لكنها بالنسبة للطيبة جزء من الملامح التي تميزها عن غيرها من الضيع والقرى. وهذه الأشياء تكوَّنت بفعل الزمن, وبفعل الطبيعة القاسية, كما لم يحصل في أماكن أخرى. فإذا كانت الأصوات العالية تميز سكان عدد كبير من القرى, حتى لتبدو أصوات الفلاحين عالية الجرْس صلبة المخارج, وبعض الأحيان سريعة, وتتخللها مجموعة من الحِكَم والأمثال, كما هي العادة لدى الكثير من الفلاحين في أنحاء عديدة من العالم, نظرًا للعادة وللمسافات التي تفصل الناس بعضهم عن بعض في الحقول, أو حين يضطرون للمناداة على الحيوانات الضالة, أو على تلك التي تذهب بمزاجها الغريب إلى أماكن بعيدة أو مجهولة, أو ربما للبعد الذي يفصل البيوت بعضها عن بعض, وما يحيط بها من الحواكير والبساتين الصغيرة التي تزرع فيها أنواع عديدة من الخضراوات - فإن هذه الأسباب, وغيرها كثير, خلقت طبيعة معينة, وجعلت الناس في الطيبة يتكلمون بطريقة خاصة, حتى ليظن مَن يسمع الحديث ولا يفهم طبيعة الناس أو علاقاتهم, أنَّهم يتعاركون, أو أن الخلاف بينهم وصل إلى درجة من الحدة, لا بدَّ أن تعقبه أمور أخرى!
لو اقتصر الأمر في الطيبة على ذلك لما عني شيئًا, خاصة بالنسبة للفلاحين أو الذين يعرفون طبائعهم. لكن إذا ترافق مع ذلك النسق الخاص من الحديث الذي تعوّده أهل الطيبة, حيث يلجأون في أكثر الأحيان إلى الاستطراد والتذكر, ويسرفون في رواية القصص والتاريخ, فإنه لولا هذه الصفة لما ظهرت تلك الطبيعة الخاصة, ولما ظهرت تلك الخشية التي تميّز البشر في ذلك المكان, وما يحيط به من قرًى وضياع, وقد تصل إلى المدينة, أو بعض أطرافها أيضًا! كان أهل الطيبة يعرفون كيف يديرون الحديث بتلك الطريقة العجيبة التي تجعل الأمور ذات أهمية شديدة. وهذه الميزة التي يتوارثها الأبناء عن الآباء, تجعلهم في نظر الكثيرين نوعًا خاصًّا من الناس, وتجعلهم أكثر من ذلك قادرين على التأثير في الآخرين, وربما إقناعهم. ولا يمكن تفسير هذا الأمر على أنه ضرب من الاحتيال أو التملُّق, كما لا يمكن أن يُعَدّ دليلاً على نزعة شريرة, ولكنها العادة بتكرارها الدائم, ثم تلك الليالي الطويلة, ليالى السمر والأحاديث السائبة, ثم التحديات, وما تجرّ إليه, وليالى الصيف أو الشتاء, في البيادر أو إلى جانب النبع, وحول المواقد. لقد كانت الأحاديث تجري سريعة شجيّة وأقرب ما تكون إلى الحلم. وكان الذين لا يحسنون المشاركة في أحاديث من هذا النوع, لا يلبثون أن يصبحوا بشرًا مختلفين إذا وُجدوا بين أناس آخرين, عندئذ يبدأون بإعادة ما سمعوا ويردّدون القصص التي رويت في الطيبة, ثم يضيفون إليها ما شاؤوا من الخيال, فتبدو وكأنَّها أقرب إلى الذكاء والمهارة, فتثير من الإعجاب بمقدار ما تثير من الحسد. وابن الطيبة, كبيرًا كان أم صغيرًا, يعرف كيف يسمع, وإن كان الصغار, بشكل خاص, أكثر قدرة على الإصغاء, ولربما ردَّدوا فيما بينهم أو في أنفسهم, ما سمعوا مرات كثيرة, حتى تترسخ في الذاكرة الأشياء فلا تضيع ولا تنسى, يضاف إليها أفكار وأمثال تَرِد عفو اللحظة وتمليها الظروف الطارئة التي يواجهونها. إنَّهم يلجأون إلى ذلك كله لكي تبدو أحاديثهم أكثر تشويقًا وأكثر أهمية! والطيبة التي تعتمد على المطر والزراعة, وعلى ذلك الشريط الضيق من الأرض الذي ترويه العين, تحسّ في أعماقها خوفًا دائمًا أن تأتي سنوات المُحْل. وإذا كانت تستعد لذلك بحرص شديد, بتربية بقرة أو اثنتين في كل بيت, وبتربية عدد من رؤوس الغنم, فإنَّها في سنوات المحل لا تستطيع أن تطعم أبناءها, ولذلك تسرف فيما تعطي للرعاة, وتحاول أن تتخلص من الدواب الباقية بذبحها أو بيعها. وبرغم أن عدد الرعاة في الطيبة أقل بكثير من القرى الأخرى, فإنَّ رُعاتها من البراعة بحيث يحسدهم الكثيرون, فالراعي الذي يسرح بغنم عشرة بيوت, ويعرف كيف يتصرف في كل الفصول, وإلى أين يذهب- هذا الراعي, برغم غيابه الطويل في الفلاة, يظهر فجأة في سنوات المحل, ويمتلك دالّة على أصحاب الغنم السابقين, بحيث ينام ويقوم في أي بيت يريد دون شعور بالحرج أو التردُّد. أمَّا المزايا الخفية التي يمتلكها الرعاة ولا تظهر للناس في المواسم الجيدة فلا تلبث أن تظهر في سنوات القحط. فهم يرابطون في مداخل القرية, ويتحوّل قسم منهم إلى الصيد, لكن العادات التي اكتسبوها في الرعي لا تفارقهم. وأهل الطيبة الذين يمتازون بقدرة خارقة على الحديث, يدركون أن الرعاة فقدوا هذه الميزة لكثرة ما عاشوا مع الحيوانات في البراري, لكنهم يعرفون كيف يستطيع هؤلاء أن يتجاوزوا الصمت بتلك الأغاني العجيبة التي يردّدونها في الفلاة, ويعرفون أيضًا كيف يستعملون تلك الآلات الخشبية, والتي لا يحسن استعمالها غيرهم, في مواسم الأعراس والحصاد, وربما في حالات الحزن أيضًا. بهذه الطريقة, وبمعرفة الأماكن التي تعيش فيها الحيوانات, يصبح الرعاة في مواسم الجفاف أُناسًا لا غنى عنهم, لكنهم في أغلب الأحيان لا يتقنون الصيد, وليست بينهم وبين الصيادين مودة. فهم لا يتخلون عن الغناء أو عن تلك الآلات الشيطانية, كما يحبّ المسنون أن يسمّوها, ويحتالون كثيرًا من أجل إبداء براعتهم في كل الأوقات, خاصة إذا تجمع الناس, وكانت هناك ضرورة من نوع ما! الطيبة بداية الصحراء. من ناحية الشرق البساتين والنبع والسوق بعد ذلك, وعند الأفق, تبدأ سلسلة الجبال. ومن ناحية الشمال والغرب تمتد سهول فسيحة, يتخلّلها بين مسافة وأخرى بعض الهضاب. وهذه السهول تزرع بأنواع كثيرة من الحبوب. كانت تزرع بالحنطة والشعير والكرسنة والبرسيم وبعض أصناف البقول, وفي الأماكن القريبة من البلدة ترتفع مساكب الخضرة, قريبًا من الأشجار المثمرة. أما من ناحية الجنوب فكانت الأرض تشحب تدريجيّا, وتخالطها الحجارة الكلسية, وتبدأ تُقفِر ذراعًا بعد آخر حتى تتحول في بداية الأفق إلى كثبان رملية, وبعد ذلك تبدأ الصحراء. في المواسم الجيدة تخضرّ الطيبة وتعبق من كل جهاتها, وتمتلئ بالورد والنباتات العجيبة الألوان والأشكال في بداية الربيع. حتى الجهة الجنوبية التي تبدو في أواخر الصيف متجهمة قاسية, لا يعرف الإنسان ولا يستطيع أن يفسر كيف كانت قادرة على أن تقذف من جوفها كل هذه الكنوز, وكيف كانت تشد أهل الطيبة في بداية الربيع لكي يذهبوا أفواجًا لالتقاط الثمار العجيبة المخبوءة في بطن الأرض, وما يخالط ذلك المهرجان من الذكريات عن أيام كانت فيها الحياة أكثر روعة وخصبًا. إن هذه البلدة تتصف بمزايا وصفات ليست متاحة لكثير من القرى المجاورة. حتى الرعاة الأغراب الذين كانوا يحلمون بالوصول إلى المراعي الخصبة, لا يجرؤون على الاقتراب كثيرًا من مراعي الطيبة, ولا يتجاوزون حدًّا معينًا, لأنهم يعرفون طباع أهل الطيبة وما يتّصفون به من حدة, وما قد يرتكبونه من حماقات إن اعتدى غريب على رزقهم أو حياتهم. هذه الأمور يعرفها ويتصف بها كل من عاش في الطيبة, ويعرفها أيضًا الذين عاشروا أهلها. وإذا كانت بعض القرى قادرة على أن تقذف من جوفها أبناء كثيرين, وترميهم في أنحاء الأرض كلها, وتفقد بعد ذلك كل صلة بهم, فإنَّ الطيبة تختلف كثيرًا, لأنها تولّد في نفوس أبنائها حنينًا من نوع لا ينسى. وحتى الذين سافروا وابتعدوا كثيرًا, كانوا يردّدون دون انقطاع اسم الطيبة, ويحنون إلى أيامها الماضية, ويتمنون لو عادوا إليها ذات يوم ليعيشوا ما تبقَّى لهم من العمر. والذين لا يذهب بهم التفكير والخيال هذا المذهب, كانوا يفكّرون في العودة إليها بين فترة وأخرى, وهناك يقضون أيامًا جميلة, ويتذكّرون كل ما حصل في سنوات سابقة, ويمرون على كل البيوت, ويجلسون في مقهى السوق ومقهى النبع, ويعبّون الهواء بقوة وشهوة لعله يمنحهم قوة تمكّنهم من مواجهة الأيام المقبلة والاستمرار في الحياة الجديدة التي بدأوا يحيونها في أماكن أخرى! وإذا كان الناس يفضلون, في بعض الأوقات, تذكّر الأيام الجميلة من الماضي, فإنَّ الأيام القاسية يصبح لها جمال من نوع خاص. حتى الصعوبات التي عاشوها تتحول في الذاكرة إلى بطولة غامضة, ولا يصدقون أنهم احتملوا ذلك كله واستمروا بعد ذلك! هذا الوفاء الذي يكنّه أهل الطيبة لبلدتهم لا يقتصر على شيء دون غيره, ولا يقتصر على المقيمين وحدهم, فالذين سافروا طلبًا للرزق أو الدراسة, وعاشوا في أماكن بعيدة, لا يكتفون بأن يرسلوا الطحين والسكر والرسائل وبعض الحاجات الأخرى إلى البلدة. إنهم يأتون لقضاء وقت غير قصير في الطيبة أيضًا, خاصة بعد أن يعجزوا عن إقناع أقربائهم بالسفر إليهم. صحيح أن هذه الفترات التي يقضونها في الطيبة تسبّب لهم ألمًا عميقًا, وتولد في النفوس أحزانًا لا يعرفون كيف يكتمونها, خاصة حين يرون المياه وهي تشحّ وتكاد تنقطع من النبع, ويرون المجرى وقد جفَّ, ثم يتملكهم شعور بالاختناق حين يسمعون أصوات الفؤوس وهي تهوي على الأشجار الجافة. فإذا أضيفت إلى ذلك أخبار الذين رحلوا وغيَّبتهم الأرض من الأصدقاء والأقرباء, الصغار والكبار, فإنَّ الحزن يتحوّل إلى حالة عصبية, ويأخذ الحديث مجرى جديدًا. يبدأ القادمون, برغم صغر سنهم, يلومون الكبار, ويوجهون لهم كلمات التقريع: - قلنا لكم مئات المرات: هذه الأرض لا تطعم حتى الجرذان, وأنتم, هنا, تتشبثون بها, وكأنَّها الجنة. اتركوها, ارحلوا إلى المدينة, هناك يمكن أن تجدوا حياة أفضل من هذه الحياة التي تعيشونها ألف مرة! وحين يصمت المقيمون, خاصة من المسنّين, ويتطلّعون بحزن إلى وجوه الذين يتكلمون, يتراءى لهم, للحظات, أنهم لم يروا هذه الوجوه, ولم يعرفوها من قبل. ويتراءى لهم في لحظات أخرى أن الكلمات التي يسمعونها قالها أناس غيرهم, أو أن المدينة أفسدتهم تمامًا وجعلتهم يتكلمون مثل هذا الكلام. وتمتد في أذهان المسنين صور لا نهاية لها, صور الطيبة في كل الفترات, حين كان العشب ينبت على الصخور وعلى سطوح المنازل, وحين كانت الينابيع تتفجر من كل مكان, كانوا يتذكرون ذلك ويعبّون أنفاسًا عميقة وكأنَّهم يتنفسون رائحة الخصوبة تتولد من كل الكائنات, ليس من البشر وحدهم, وإنما أيضًا من الحيوانات والجماد. يتذكرون كل شيء, ويتذكرون أكثر مذاق الأطعمة التي كانوا يأكلونها فيتحرّك اللعاب في أفواههم! وبرغم أن الأبناء الذين هجروا الطيبة منذ وقت طويل, واستقرّوا في المدينة البعيدة, لا يعنون ما يقولونه تمامًا, أو لا يقصدون إليه, فإنَّ تلك الصعوبات التي كثيرًا ما تتكرر, تحملهم على أن يقولوا كل شيء, وتحملهم أكثر على أن يفكروا بهذه الطريقة. ومع ذلك, وبالرغم منه, فإنَّ هؤلاء في مواطنهم الجديدة لا يكفّون عن ذكر الطيبة, والحديث عن مزايا موهومة لا تتمتع بها أي بلدة أخرى في المنطقة كلها. كان هؤلاء الأبناء لا يكتفون بالحديث, فإنَّ تعلقهم بالطيبة يدفعهم في حالات كثيرة, وفي لحظات الشوق المذكِّرة, لأن يفعلوا أشياء لا حصر لها ولا تخطر ببال: كانوا يقيمون أفراحهم في الطيبة, يجدّدون هذه الأفراح في الطيبة, يبعثون أبناءهم خلال فصول الصيف, لكي يعيشوا مثلما عاشوا حين كانوا صغارًا. وحين تأخذهم النشوة يدعون أصدقاءهم لقضاء بضعة أيام في هذه البقعة الرائعة: (في الطيبة السماء قريبة, شديدة الصفاء, والليالي هناك مليئة بنشوة لا تجدونها في أي مكان آخر من هذا العالم. أما الفواكه, أما الألبان, كالجبنة حين تكون طازجة, والزبدة حين تقطف, والدجاج والخراف الصغيرة وهي تشوى على نار الحطب... أما هذه الأشياء وأخرى وغيرها في الطيبة, فلا يمكن أن يكون لها مثيل. ثم هناك الصيد. الصيد وفير, فالحَجَل والأرانب, وحتى الحيوانات المتوحشة التي انقرضت في معظم البقاع, يمكن أن توجد في بعض الأودية العميقة المحيطة بالطيبة. والينابيع الغزيرة, إن الينابيع, إذا كانت أمطار تلك السنة وفيرة, تتفجّر من شقوق الأرض, وتتدفّق من تحت كل صخرة. ومياه هذه الينابيع باردة نقية, حتى إن الإنسان لا يشبع حين يشرب من تلك المياه). هكذا كانت الأحاديث تجري. أما إذا جاءت فاكهة الطيبة إلى المدينة, في سلال صغيرة, فكان هؤلاء الأبناء لا يملّون أبدًا من تقليبها والنظر إليها. كانوا يفضلون أن يقدّموها إلى ضيوفهم, وأن يتحدثوا عنها. أما إذا جرى الحديث عن أجبان المدينة وألبانها, فكثيرًا ما كانت وجوه هؤلاء الأبناء تتغير, تمرق مثل ومضات خاطفة مظاهر القرف والذكرى في وقت واحد, ويتصورون للحظات أنهم غير قادرين على أن يتذوّقوا شيئًا من الطعام غير ذاك الذي يأتي من الطيبة! أشياء كثيرة تتولّد في النفوس, في نفوس المقيمين والراحلين, وهذه الأشياء من التداخل والتعقيد بحيث لا يستطيع أحد أن يفسرها. يتبع،،، |

|
|
|
#6 |
|
تميراوي فضي
|
ابو عبد الكريم تكف لا تعلقنا كمل القصه .. والله يستر من القحط ..
فمؤشرات القحط بانت في الأفق لدينا .. الطمع والغلا وانحباس المطر وانتشار الامراض الحيوانيه وموتها . فالبشكر تزيد النعم ... لكن مايحصل ونشاهده الآن هو كفر النعمه .. نسأل الله أن يرحمنا برحمته .. شاكرا لك أخي العزيز هذا الطرح ..!! |
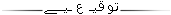
شكر خاص لكل من قام بتقييمي اثناء غيابي ... !!!!

|
|
|
#7 |
|
تميراوي سوبر
|
مشكور اخوي على الموضووع.......والله يعطيك العافية
|
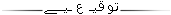

|
|
|
#8 |
|
تميراوي
|
صحيح أن الطيبة, مثل أماكن أخرى كثيرة, شحيحة الأرض, قليلة المياه, لكن فيها شيئًا يجذب الإنسان ويشدّه إليها شدّا محكمًا. وإذا بدأ المسنّون الحديث, في السهرات الطويلة خلال الصيف, فإنَّهم يتحدثون بلغة تروق كثيرًا لهؤلاء الذين أتوا من المدينة. (قبل سنين كثيرة كانت الجبال المحيطة بالطيبة خضراء مثل البساتين, لكن الأتراك, وهم يبنون سكة الحديد, ثم وهم يسيّرون القطارات, لم يتركوا شجرة إلاَّ وقطعوها. كانوا يريدون أخشابًا, ولا يهمّهم من أين. والأشجار التي لم يستطيعوا الوصول إليها, التي كانت في المعاصي وفي قمم الجبال, أحرقوها وهم يرحلون. أما الجبال التي ترونها عارية الآن من المدينة البعيدة وحتى الطيبة, فقد رأيناها خضراء حين كنا صغارًا. كان الفارس يضيع في الغابات الكثيفة التي تملأ السهول القريبة من الطيبة). مثل هذه الأحاديث توقد في الأذهان صورًا لا نهاية لها, وأبناء الطيبة الذين سمعوها مرات كثيرة, كان يروق لهم أن يدفعوا المسنين لاستعادتها مرات ومرات, خاصة وهم يستقبلون ضيوفًا من المدينة. كانوا يريدون, بطريقة غامضة, أن يثبتوا ميزة خاصة لبلدتهم. وهذه الميزة, وإن كانت لا تظهر بالوضوح الذي يشتهون في الوقت الحاضر, فإنَّها تكمن في مكان ما, ولا بدَّ أن تظهر. ويضيفون بمكر وغموض: (ليس هناك أفضل من أن يقضي الإنسان أيامه الأخيرة في هذه البلدة المباركة). وبالمكر نفسه, يدفعون المسنّين لأن يتحدّثوا عن الأعمار. وهذا الحديث الذي يروق لبعض الرجال, كان يزعج النساء ويدفعهن إلى المقاطعة, وبعض الأحيان إلى الاستفزاز, لكن لا يكاد الحديث يأخذ مجرى جدّيًّا مرة أخرى, حتى يتحدث المسنّون عن نقاوة الهواء وعذوبة الماء, ويتحدثوا عن فوائد النوم المبكر واليقظة المبكرة, ثم نوع الأكل الذي يأكلونه, ويعزون الأمراض الجديدة والموت المبكر والمفاجئ, الذي يداهم المدينة, إلى مجموعة من الأسباب لم يألفوها ولم يسمعوا بها من قبل! وأحاديث السهر تبدأ دون منطق وبلا نظام, وقد يتخللها بعض الألعاب البريئة. وتلك الأمور تجري عفوًا للحظة, وبلا تخطيط سابق. ومهما تشعّبت وتباعدت, ومثلما بدأت بالغابات والأشجار والينابيع, فلا بدَّ أن يجري الحديث أيضًا عن أيام القحط والصعوبات التي عاشتها الطيبة خلال تلك السنين. وإذا كانت اللذة والأيام الرائعة المليئة بالخصب تحرّك المشاعر, فإن المصاعب التي عاشها البشر وتغلبوا عليها تحرك مشاعر أخرى, مشاعر تزخر بالقوة وبعظمة من نوع خاص, حتى أبناء الطيبة الذين سمعوا هذه الأحاديث مرات كثيرة, يلذّ لهم أن يسمعوها من جديد, وفي كل مرة تبدو لهم جديدة مليئة بالبطولة والعبر: (كنا نأكل الأعشاب وجذور النباتات. كنا نأكل الجرابيع. حتى الجراد الذي كثيرًا ما كان يأتي في سنوات المحل, أو الذي يسبّب المحل, كنا نأكله. صحيح أن الحياة آنذاك كانت في منتهى القسوة والصعوبة, لكن الرجال في تلك الأيام كانوا رجالاً, كانوا أقوياء وقادرين على الاحتمال والصبر, وكانوا قادرين على أن يأكلوا الصخر. أما رجال هذه الأيام...). ويبتسم بعض المسنّين, ويتذكر الآخرون. وينظرون بعضهم في وجوه بعض, وبعضهم في وجوه أبنائهم, ثم في وجوه الضيوف! هذا جزء مما تعنيه الطيبة في ذاكرة أبنائها. أما إذا جاء القحط فلا يبقي أحد من أهل الطيبة, سواء كان يعيش فيها أو كان بعيدًا عنها, إلاَّ ويحس بمرض من نوع ما, ولا يلبث هذا المرض أن يتحول إلى هاجس ثم إلى كابوس. وبرغم أن الأبناء البعيدين لا يحتاجون إلى مَن يحرّضهم لكي يجيئوا أو يبعثوا إلى البلدة بكل ما يستطيعون, فإنَّ هذه المساعدات لا تقوي على مواجهة الكرب والوقوف في وجه المصائب التي تتوالى بسرعة. فحين يبدأ النبع يتراخى والساقية تضمر, ثم تجف في نهايتها, يصبح المجرى مثل حيّة ماتت لتوّها وبدأت تتخلى عن قشرتها. وفي هذه الأوقات تبدأ الأشجار بالذبول, ثم الجفاف. كانت أشجار المشمش أولى الأشجار التي تموت, ثم تبدأ بعد ذلك الأشجار الأخرى. وتبور مواسم الجوز والزيتون, وتصبح الطيبة كالحة قبيحة, ويغلب عليها لون الصفرة. ومن ناحية الجنوب, بدل الفقع والكماء والحميض والأنواع الكثيرة من الفطر, تبدأ عواصف الرمال تهبّ لتغطي كل شيء, وتخيّم على سماء الطيبة موجة من الغبار الممرض, وتتكاثر أفواج الذباب والغربان على الفطائس وعلى بقايا البراز, وتتحوَّل الأصوات إلى دويّ مكتوم ينذر بشؤم ما. وفي هذه السنين لا بدَّ أن يموت عدد كبير من الناس. ولا بدَّ أن تحصل أشياء لم يقدّرها الكثيرون! لا تقتصر هذه الحالة على البشر, إذ تمتد إلى الحيوانات والطيور, فالحيوانات التي كانت تملأ منطقة شاسعة حول الطيبة وتسرح بلا مبالاة ورخاوة, وتقضي جزءًا من نهاراتها في سكينة أقرب إلى الدعة من الشبع والامتلاء, لا تلبث أن تتحول إلى حيوانات نزقة شديدة الجفلة كثيرة الحركة, بحثًا عن شيء تأكله, ثم تتحوّل إلى الشراسة والعناد, فتبدو هائجة, ويمكن أن تتصرف بجموح يصل درجة الأذى. وأخيرًا يضربها الهزال والمرض, وفي هذه الحالة يتراكض أصحابها بعصبية لكي يتخلصوا منها بالذبح أو البيع. أما الطيور التي تعبر سماوات كثيرة متجهة إلى حيث تجد رزقها, فقد كانت تعبر سماء الطيبة بسرعة ودون أن تتوقف, وكأنَّها بغريزة غامضة, ومنذ أزمان موغلة في القدم, وبتوارث فذ, تعرف كيف تتجاوز الطيبة وإلى أين تذهب, عدا تلك الطيور الصحراوية القاسية الملعونة, فقد كانت تترك أماكن كثيرة في هذا العالم وتتجه إلى الطيبة أو قريبًا منها, وتبدأ من هناك معركتها الأزلية مع البشر وبقايا الحب وقطرات الماء. وإذا كان لكل مدينة وبلدة وقرية جنونها ومجانينها, فإن جنون الطيبة أنواع كثيرة, لكن نوعًا خاصًّا, أكثر من غيره, يظهر في سنوات الجفاف. وهذا النوع يطغى على غيره ويكاد يكون الوحيد. إنه جنون الصيد. حتى الذين لا يمارسون هذه الهواية, وينظرون إليها نظرة تتراوح بين الزراية والرفض, ويفسرونها على أنها أقرب إلى الغفلة ورغبة الكسل, فإنَّهم يكتشفون فجأة في أنفسهم حنينًا موجعًا لأن يصبحوا صيادين بشكل ما. قد تدفعهم إلى ذلك الرغبة لتأمين الرزق, أو لطرد الطيور الجارحة والانتقام منها, لعل بعض الحبوب تبقي وتنبت في السنة التالية, أو لعل تلك الحبوب تتفتح عن بعض أوراق خضراء تأكلها الحيوانات الجائعة. وربما كان الدافع إلى ذلك كله الرغبة في الانتقام من عدوٍّ ما! كان مجانين الطيبة في هذه السنة أكثر عددًا وأكثر صخبًا من أي سنة سابقة. حتى في سنة المجاعة الكبيرة, التي أعقبت الحرب, لم يظهر مثل هذا العدد, ولم تظهر مثل هذه الحالة. إذ ما كاد موسم الصيد يبدأ حتى أخرج هؤلاء المجانين البنادق القديمة من مخابئها, مسحوا عنها الغبار, نظَّفوها جيدًا, وبدأوا يضعون الخطط ويتحدثون. لم يكتفوا بذلك, ابتدعوا وسائل صيد جديدة, وتفنَّنوا في تحضير الخرطوش واختراعه. ولكي ينتقم أولئك المجانين, المصابون بهذا المرض منذ وقت طويل, من أيام ماضية, حين كانوا سخرية أهل الطيبة, لجأوا إلى المكر والدهاء, فلم يتركوا أحدًا إلاَّ وأغروه بالصيد. وأكَّدوا أن هذه الطريقة وحدها يمكن أن تنقذ البلدة. ولكي ينجحوا في لعبتهم حتى النهاية وزّعوا على الكثيرين, مجانًا, عددًا من الخرطوش الذي يصنعونه بأيديهم وبوسائلهم البدائية, واتخذوهم مساعدين لهم في تحضير كل ما من شأنه أن يسهل مهمتهم, وقالوا بصوت واضح: (ليس أسهل من الصيد, ولكي يصبح الإنسان صيَّادًا يجب أن يمارس الصيد, تمامًا مثلما يتعلم السباحة). والذين استمعوا إليهم بانتباه لم يصدقوا آذانهم, أول الأمر, لكن الإغراء الخفي الماكر جرّ الكثيرين, فيومًا بعد يوم كان مجانين آخرون ينضمّون إلى مجانين البلدة, وكان الوافدون الجدد يمتلئون زهوًا حين تصيب طلقاتهم طيرًا من الطيور, وبين عشية وأخرى يتحولون إلى مهووسين لا يعرفون الراحة والهدوء إلاَّ بالقتل والركض وراء الطيور من مكان إلى آخر. يتبع،،،، |

|
|
|
#9 |
|
تميراوي
|
هكذا بدأت اللعبة أول الأمر, وهي وإن بدأت صغيرة خفية, فقد أثارت حنق عدد كبير من المسنين, ومن الذين ينظرون إلى الصيد على أنه وسيلة للرزق والحياة. لقد كانت اللعبة أقرب إلى العبث ولا تناسب الرجال الذين يقدّرون مسؤولياتهم, ويجب أن ينشغلوا بالهموم الكبيرة التي أخذت تزداد يومًا بعد آخر. لكن اللعبة تكبر وتتسع كل يوم. والذين أبدوا بعض التردّد ما لبثوا أن تراجعوا, خاصة حين أخذوا يشاهدون طيور القطا محمولة بالعشرات. أما حين يقلبونها ليتأكدوا من كمية اللحم فيها فكانوا يقولون بصوت عال: - ضعيفة.. نعم إنها أضعف من أي سنة سابقة! ولكي يتأكدوا من أن ما يقولونه هو الحقيقة, كانوا يقلّبونها مرة أخرى, ويشدّون على صدورها. وبهذه الحركات الإضافية, وبضغط الأصابع على اللحم الطري, كانت مواقفهم تتغير ويحسّون برغبة مغرية. أمَّا حين يبدأون بعدّها فكان التردّد يتراجع مع كل رقم جديد, لكن دون إعلان, ودون كلمات, ويكون كل واحد منهم قد اتخذ قرارًا داخليًّا أن يبدأ اللعبة! والمسنّون الذين صرخوا بغضب, وعدُّوا هذا الهوس نوعًا من الفتنة أو الجنون, ولا يليق بالرجال في مثل هذه المحنة القاسية, ما لبثوا أن تراجعوا. صحيح أنهم لم يفعلوا ذلك سريعًا وبشكل علني, لكن اعتراضاتهم بدأت تقل وتتراجع يومًا بعد آخر, وبدأت كلماتهم تأخذ طابعًا ليّنًا أقرب إلى النصح: - اذهبوا إلى المدينة واعملوا هناك. أما أن تنتشروا في هذه الأرض الغبراء, وأن تتشردوا بين الجبال والصحراء, من أجل طيور جائعة, وليس فيها سوى العصب والريش, فإنَّ ذلك مضيعة للوقت. وحين يهزّ الشباب رؤوسهم إشارة إلى أنهم سمعوا ما قاله المسنّون, دون أن تعني الإشارة موافقة أو رفضًا, كان بعض المسنّين يضيف: - إذا جاءت المصائب فإنَّها تجيء مرة واحدة! وتستمرّ اللعبة تكبر, ويستمر الشباب في ترتيب لوازم الصيد لليوم التالي: يهيّئون الخرطوش, ينظّفون البنادق, يصنعون قطعًا من القماش الملون الملئ بالثقوب لاستدراج الطيور والاحتيال عليها. وحين يرى المسنّون ذلك, ويجدون لدى الشباب إصرارًا لا يتزعزع, كانت لهجة الكثيرين تصبح أكثر حنوًّا وخوفًا: - هذا البارود يأكل الأخضر واليابس, يجب أن تحذروا! ويرقب المسنّون بعناية الطريقة التي يُصنع بها الخرطوش ليتأكّدوا من أن الشباب يفعلون ذلك دون ما خطإ. فإذا تأكَّدوا كانت كلمة وحيدة تتكرر بلا انقطاع: - كل البلاء من المجنون الكبير عساف! عسّاف الرجل الذي يعرفه أهل الطيبة كلهم, نساءً ورجالاً, كبارًا وصغارًا, هو نفسه عساف الذي يبدو غامضًا ومجهولاً بالنسبة للجميع, وقلما يراه أو يجلس معه أحد. بين الأربعين والخمسين, طويل مع انحناءة صغيرة, ضامر لكنه قوي البنية, أعزب لأسباب يختلف فيها الناس كثيرًا. قيل إنه كان يريد ابنة عمه, لكن أباها رفض (لأن عسافًا بلا عمل ولا يستطيع أن يعول نفسه, فكيف إذا تزوَّج وجاءه أولاد)? وقيل إن الفتاة رفضت وهدَّدت أن تحرق نفسها إن هم أجبروها على الزواج به, وتعللت بغرابة الطبع والقسوة. وحين سئلت أمها, في وقت متأخر, أبدت استنكارها الشديد, وقالت إن حذاء ابنتها يعادل رأس هذا المتشرد الذي يعيش في البراري والمغارات, ووصفته بالمجنون أيضًا. ولو حاول أي إنسان التحري عن أسباب أخرى لوجد الكثير. إن هذه القضية التي شغلت الطيبة وقتًا ما انتهت بصمت وهدوء, ولم تعد تشغل أحدًا. أما ما خلّفته من نتائج فاسم جديد لعساف: أبو ليلى. وبعض الذين استمروا يبدون اهتمامًا بهذا الأمر, تحوَّل لديهم هذا الاهتمام مع الأيام إلى نوع من الطرافة والسخرية, خاصة وأن عسافًا يرفض الإجابة عن أي سؤال له علاقة بهذا الموضوع. وهكذا تعوَّد الناس أن يكون عساف بهذا الشكل, ولو ظهر بشكل آخر لبدا غريبًا! منذ كان صغيرًا شغلته قضية الصيد, وهذه القضية كبرت عامًا بعد عام ما دام عساف يكبر. وإذا كانت بسيطة وبدائية حين كان صغيرًا, ويفعل ما يفعله الصبيان في مثل عمره, فقد كان أكثرهم ولعًا وتعلقًا. أما حين مات أبوه, فقد استغرق في هذه الهواية الخطرة. لم يعد يكتفي بما يفعله الصغار. كان يقلد الكبار ويذهب حيث يذهبون, وكان يحاول باستمرار ابتداع وسائل جديدة للصيد. ونتيجة لهذا الوضع فقد اكتسب عادات خاصة أقرب إلى الغرابة. كان يقضي وقته في البساتين, بدأ التدخين في سنّ مبكرة, أصبح كثير التفكير والتأمل في كل ما حوله من طبيعة وبشر وحيوانات, وكان في أغلب الأحيان بعيدًا عن الناس, أما حين يكون بينهم فالصمت سلاحه تجاه الآخرين. ظلَّ يتطور بهذا الشكل, وحين ماتت أُمه, تغيّرت طباعه أكثر من قبل, فبدل أن يعود إلى البلدة ويصبح مثل الآخرين, يزرع ويحصد ويستقر, فقد اشترى بندقية صيد من النوع القديم. وبدا الأمر غريبًا أن يكون فتًى في الثالثة عشرة يقلد الكبار ويلاحق الطيور التي لا يفكّر فيها مَن كان في عمره, وأن يقضي وقته كله خارج البلدة وحيدًا ينتقل من وادٍ إلى آخر ومن جبلٍ إلى آخر. إن أجزاء كبيرة من حياة عساف بعد ذلك مجهولة, وحتى لو أراد هو نفسه أن يستعيد حياته, فلن يتذكر إلاَّ الشيء القليل, لن يتذكر أحداثًا كبيرة أو مهمة, سوى تلك التي لها علاقة بالصيد: أين ضرب الذئب? وكيف ضربه? كم مرة اضطر للنوم في المغارات خوفًا من الموت بردًا, بعد أن سقط الثلج وتراكم بكثافة ليسد الطرق ويجعل الحركة صعبة? ويتذكر عدد المرات التي رفض أن يضرب إناث الحجل لأنها كانت تسوق أمامها أفراخها الصغيرة. إن هذه الذكريات وما يشبهها لا تعني أحدًا غيره, وحتى لو أراد أن يتحدث فإنَّ حديثه يبدو غامضًا متداخلاً, ولا يستطيع أحد أن يتابعه! هذا النوع من البشر يتحول يومًا بعد آخر إلى حالة من الغرابة والانطواء, ويصبح بطبيعته أميل إلى الابتعاد عن الناس أو الاهتمام بهم, كما أن له عالمه الخاص وهمومه التي لا يشاركه فيها الآخرون. أما طريقته في التعبير فتكون قاسية فظة, وقد تؤذي إذا لم تفهم هذه الطبيعة ويحسن التعامل معها. والطيبة, التي عرفت أنماطًا كثيرة من البشر, تعوّدت على عساف كما تعودت على هذه الأنماط, ولم يعد مظهره الرثّ أو صمته, وحتى الشتائم التي يطلقها في بعض الأحيان, إذا حاصره أحد وانهالت عليه الأسئلة والاستفزازات, لم تعد هذه الأمور تثير حرجًا أو خصومات, إذ ما تكاد تبدأ حتى تأخذ شكلاً ساخرًا أوَّل الأمر ثم ضاحكًا في النهاية. وعساف الذي تعوَّد على هذه الحياة كان يجد صعوبة كبيرة في أن يغيرها. وفي المرات القليلة التي كان يضطر فيها إلى استبدال بعض من ملابسه يفعل أشياء لا تخطر على بال ولا يفعلها أي عاقل. فحين يبلي حذاؤه ويكون مضطرًّا لشراء حذاء جديد, لا يستطيع أن يستعمل الحذاء الذي يشتريه مباشرة; فكان يدخل عليه تعديلات كبيرة, تفسده في بعض الحالات. كان يلجأ إلى قصّ الجلد عند الأصبعين الصغيرين, وكان يضرب الحذاء ضربات قوية بعد أن يضعه في الماء. ولو سأله أحد عن ذلك لما كان لديه شيء يقوله, حتى هو لا يعرف لماذا يفعل ما يفعله. ولو اقتصر الأمر على الأحذية لهان وفُهم, لكنه كان يفعل بملابسه شيئًا مماثلاً, كان يمزق السراويل في مواضع كثيرة, وفي تلك المواضع يخيط عددًا من الرقع الملونة, وفي بعض الأحيان قطعًا من الجلد الطري. إن هذا شأن من شؤونه, ولا يستطيع أحد أن يناقشه أو يقنعه بغير ذلك. أما في أيام الأعياد, وحين يكون مضطرًّا إلى أن يمر على معظم بيوت الطيبة, كما هي العادة, فكان لا يغيّر شيئًا في مظهره, كما تعوَّد الناس أن يفعلوا, وقد يبالغ فيلبس أسوأ ما في غرفته الصغيرة, وهي الغرفة الوحيدة التي بقيت له بعد أن باع البستان أوَّل الأمر, ثم باع بعد ذلك جزءًا من الدار, ولم يبق إلاَّ على الغرفة الداخلية وحاكورة صغيرة. يتبع،،، |

|
|
|
#10 |
|
تميراوي
|
هكذا بدأت اللعبة أول الأمر, وهي وإن بدأت صغيرة خفية, فقد أثارت حنق عدد كبير من المسنين, ومن الذين ينظرون إلى الصيد على أنه وسيلة للرزق والحياة. لقد كانت اللعبة أقرب إلى العبث ولا تناسب الرجال الذين يقدّرون مسؤولياتهم, ويجب أن ينشغلوا بالهموم الكبيرة التي أخذت تزداد يومًا بعد آخر. لكن اللعبة تكبر وتتسع كل يوم. والذين أبدوا بعض التردّد ما لبثوا أن تراجعوا, خاصة حين أخذوا يشاهدون طيور القطا محمولة بالعشرات. أما حين يقلبونها ليتأكدوا من كمية اللحم فيها فكانوا يقولون بصوت عال: - ضعيفة.. نعم إنها أضعف من أي سنة سابقة! ولكي يتأكدوا من أن ما يقولونه هو الحقيقة, كانوا يقلّبونها مرة أخرى, ويشدّون على صدورها. وبهذه الحركات الإضافية, وبضغط الأصابع على اللحم الطري, كانت مواقفهم تتغير ويحسّون برغبة مغرية. أمَّا حين يبدأون بعدّها فكان التردّد يتراجع مع كل رقم جديد, لكن دون إعلان, ودون كلمات, ويكون كل واحد منهم قد اتخذ قرارًا داخليًّا أن يبدأ اللعبة! والمسنّون الذين صرخوا بغضب, وعدُّوا هذا الهوس نوعًا من الفتنة أو الجنون, ولا يليق بالرجال في مثل هذه المحنة القاسية, ما لبثوا أن تراجعوا. صحيح أنهم لم يفعلوا ذلك سريعًا وبشكل علني, لكن اعتراضاتهم بدأت تقل وتتراجع يومًا بعد آخر, وبدأت كلماتهم تأخذ طابعًا ليّنًا أقرب إلى النصح: - اذهبوا إلى المدينة واعملوا هناك. أما أن تنتشروا في هذه الأرض الغبراء, وأن تتشردوا بين الجبال والصحراء, من أجل طيور جائعة, وليس فيها سوى العصب والريش, فإنَّ ذلك مضيعة للوقت. وحين يهزّ الشباب رؤوسهم إشارة إلى أنهم سمعوا ما قاله المسنّون, دون أن تعني الإشارة موافقة أو رفضًا, كان بعض المسنّين يضيف: - إذا جاءت المصائب فإنَّها تجيء مرة واحدة! وتستمرّ اللعبة تكبر, ويستمر الشباب في ترتيب لوازم الصيد لليوم التالي: يهيّئون الخرطوش, ينظّفون البنادق, يصنعون قطعًا من القماش الملون الملئ بالثقوب لاستدراج الطيور والاحتيال عليها. وحين يرى المسنّون ذلك, ويجدون لدى الشباب إصرارًا لا يتزعزع, كانت لهجة الكثيرين تصبح أكثر حنوًّا وخوفًا: - هذا البارود يأكل الأخضر واليابس, يجب أن تحذروا! ويرقب المسنّون بعناية الطريقة التي يُصنع بها الخرطوش ليتأكّدوا من أن الشباب يفعلون ذلك دون ما خطإ. فإذا تأكَّدوا كانت كلمة وحيدة تتكرر بلا انقطاع: - كل البلاء من المجنون الكبير عساف! عسّاف الرجل الذي يعرفه أهل الطيبة كلهم, نساءً ورجالاً, كبارًا وصغارًا, هو نفسه عساف الذي يبدو غامضًا ومجهولاً بالنسبة للجميع, وقلما يراه أو يجلس معه أحد. بين الأربعين والخمسين, طويل مع انحناءة صغيرة, ضامر لكنه قوي البنية, أعزب لأسباب يختلف فيها الناس كثيرًا. قيل إنه كان يريد ابنة عمه, لكن أباها رفض (لأن عسافًا بلا عمل ولا يستطيع أن يعول نفسه, فكيف إذا تزوَّج وجاءه أولاد)? وقيل إن الفتاة رفضت وهدَّدت أن تحرق نفسها إن هم أجبروها على الزواج به, وتعللت بغرابة الطبع والقسوة. وحين سئلت أمها, في وقت متأخر, أبدت استنكارها الشديد, وقالت إن حذاء ابنتها يعادل رأس هذا المتشرد الذي يعيش في البراري والمغارات, ووصفته بالمجنون أيضًا. ولو حاول أي إنسان التحري عن أسباب أخرى لوجد الكثير. إن هذه القضية التي شغلت الطيبة وقتًا ما انتهت بصمت وهدوء, ولم تعد تشغل أحدًا. أما ما خلّفته من نتائج فاسم جديد لعساف: أبو ليلى. وبعض الذين استمروا يبدون اهتمامًا بهذا الأمر, تحوَّل لديهم هذا الاهتمام مع الأيام إلى نوع من الطرافة والسخرية, خاصة وأن عسافًا يرفض الإجابة عن أي سؤال له علاقة بهذا الموضوع. وهكذا تعوَّد الناس أن يكون عساف بهذا الشكل, ولو ظهر بشكل آخر لبدا غريبًا! منذ كان صغيرًا شغلته قضية الصيد, وهذه القضية كبرت عامًا بعد عام ما دام عساف يكبر. وإذا كانت بسيطة وبدائية حين كان صغيرًا, ويفعل ما يفعله الصبيان في مثل عمره, فقد كان أكثرهم ولعًا وتعلقًا. أما حين مات أبوه, فقد استغرق في هذه الهواية الخطرة. لم يعد يكتفي بما يفعله الصغار. كان يقلد الكبار ويذهب حيث يذهبون, وكان يحاول باستمرار ابتداع وسائل جديدة للصيد. ونتيجة لهذا الوضع فقد اكتسب عادات خاصة أقرب إلى الغرابة. كان يقضي وقته في البساتين, بدأ التدخين في سنّ مبكرة, أصبح كثير التفكير والتأمل في كل ما حوله من طبيعة وبشر وحيوانات, وكان في أغلب الأحيان بعيدًا عن الناس, أما حين يكون بينهم فالصمت سلاحه تجاه الآخرين. ظلَّ يتطور بهذا الشكل, وحين ماتت أُمه, تغيّرت طباعه أكثر من قبل, فبدل أن يعود إلى البلدة ويصبح مثل الآخرين, يزرع ويحصد ويستقر, فقد اشترى بندقية صيد من النوع القديم. وبدا الأمر غريبًا أن يكون فتًى في الثالثة عشرة يقلد الكبار ويلاحق الطيور التي لا يفكّر فيها مَن كان في عمره, وأن يقضي وقته كله خارج البلدة وحيدًا ينتقل من وادٍ إلى آخر ومن جبلٍ إلى آخر. إن أجزاء كبيرة من حياة عساف بعد ذلك مجهولة, وحتى لو أراد هو نفسه أن يستعيد حياته, فلن يتذكر إلاَّ الشيء القليل, لن يتذكر أحداثًا كبيرة أو مهمة, سوى تلك التي لها علاقة بالصيد: أين ضرب الذئب? وكيف ضربه? كم مرة اضطر للنوم في المغارات خوفًا من الموت بردًا, بعد أن سقط الثلج وتراكم بكثافة ليسد الطرق ويجعل الحركة صعبة? ويتذكر عدد المرات التي رفض أن يضرب إناث الحجل لأنها كانت تسوق أمامها أفراخها الصغيرة. إن هذه الذكريات وما يشبهها لا تعني أحدًا غيره, وحتى لو أراد أن يتحدث فإنَّ حديثه يبدو غامضًا متداخلاً, ولا يستطيع أحد أن يتابعه! هذا النوع من البشر يتحول يومًا بعد آخر إلى حالة من الغرابة والانطواء, ويصبح بطبيعته أميل إلى الابتعاد عن الناس أو الاهتمام بهم, كما أن له عالمه الخاص وهمومه التي لا يشاركه فيها الآخرون. أما طريقته في التعبير فتكون قاسية فظة, وقد تؤذي إذا لم تفهم هذه الطبيعة ويحسن التعامل معها. والطيبة, التي عرفت أنماطًا كثيرة من البشر, تعوّدت على عساف كما تعودت على هذه الأنماط, ولم يعد مظهره الرثّ أو صمته, وحتى الشتائم التي يطلقها في بعض الأحيان, إذا حاصره أحد وانهالت عليه الأسئلة والاستفزازات, لم تعد هذه الأمور تثير حرجًا أو خصومات, إذ ما تكاد تبدأ حتى تأخذ شكلاً ساخرًا أوَّل الأمر ثم ضاحكًا في النهاية. وعساف الذي تعوَّد على هذه الحياة كان يجد صعوبة كبيرة في أن يغيرها. وفي المرات القليلة التي كان يضطر فيها إلى استبدال بعض من ملابسه يفعل أشياء لا تخطر على بال ولا يفعلها أي عاقل. فحين يبلي حذاؤه ويكون مضطرًّا لشراء حذاء جديد, لا يستطيع أن يستعمل الحذاء الذي يشتريه مباشرة; فكان يدخل عليه تعديلات كبيرة, تفسده في بعض الحالات. كان يلجأ إلى قصّ الجلد عند الأصبعين الصغيرين, وكان يضرب الحذاء ضربات قوية بعد أن يضعه في الماء. ولو سأله أحد عن ذلك لما كان لديه شيء يقوله, حتى هو لا يعرف لماذا يفعل ما يفعله. ولو اقتصر الأمر على الأحذية لهان وفُهم, لكنه كان يفعل بملابسه شيئًا مماثلاً, كان يمزق السراويل في مواضع كثيرة, وفي تلك المواضع يخيط عددًا من الرقع الملونة, وفي بعض الأحيان قطعًا من الجلد الطري. إن هذا شأن من شؤونه, ولا يستطيع أحد أن يناقشه أو يقنعه بغير ذلك. أما في أيام الأعياد, وحين يكون مضطرًّا إلى أن يمر على معظم بيوت الطيبة, كما هي العادة, فكان لا يغيّر شيئًا في مظهره, كما تعوَّد الناس أن يفعلوا, وقد يبالغ فيلبس أسوأ ما في غرفته الصغيرة, وهي الغرفة الوحيدة التي بقيت له بعد أن باع البستان أوَّل الأمر, ثم باع بعد ذلك جزءًا من الدار, ولم يبق إلاَّ على الغرفة الداخلية وحاكورة صغيرة. يتبع،،، |

|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 |
 |
 |