




 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
| النبض العام يختص باخبار المنتدى و القرارات الادارية و المواضيع التفاعلية والمسابقات و الطرح العام |
 آخر 10 مشاركات
آخر 10 مشاركات
|
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#11 |
|
تميراوي
|
هكذا تعوَّد أهل الطيبة على عساف, ونتيجة الألفة والاستمرار, لم يعد يثير تساؤلاً أو استنكارًا. الشيء الوحيد الذي أثار اهتمام الناس ذات يوم, ولم يستمر هذا الشيء طويلاً, أن عسافًا اقتنى كلبًا. ولقد بالغ كثيرًا, حين سئل عن الكلب, في الحديث عن أهميته وأصله, وبالغ أكثر من ذلك في تحديد المبلغ الذي دفعه ثمنًا له. وقد قيل مرات كثيرة إن عسافًا وجد الكلب ضائعًا, ربما من صياد غريب, فجاء به. وتجرأ بعض الناس في الطيبة وقال إن عسافًا سرقه! وعساف الذي سمع بعض ما يقوله الناس, كان يبتسم دون اهتمام, ويطبطب على ظهر الكلب بمودة, ويقول له: (اسمع ما يقول الهبل). وخلال هذه الفترة قضى عساف وقتًا أطول مما تعوَّد في البيت, وقضى بعد ذلك أسبوعين في الطيبة, لم يخرج خلالهما إلى الصيد. وقد فسّر الأمر بالخوف . فالذين قالوا إنه سرق الكلب, كانوا متأكدين من ذلك أكثر من ذي قبل, لأن الأمر لو كان له سبب آخر لما خشي عساف الخروج إلى الصيد واصطحاب كلبه معه. أمَّا الذين قالوا إن عسافًا وجده, فقد كانوا على يقين أن الكلب سيعود إلى أصحابه حالما يخرج من الدار ويصبح حرًّا, ولن يستطيع عساف أن يفعل شيئًا لو هرب الكلب وعاد إلى أصحابه! أما الحقيقة فهي أن عسافًا لا يثق إلاَّ بما يفعله, ولا يتأكد إلاَّ إذا فعل الشيء بنفسه, ولذلك, وبعد أن رافق صيادين جاءوا إلى الطيبة من مكان بعيد, ونتيجة للجهد الذي بذله معهم, ولأنه دلّهم على أماكن مناسبة للحجل, ثم تنازل لهم عن الطيور الخمسة التي اصطادها, أعطوه ذلك الكلب. لكن عسافًا لم يكن واثقًا بالكلب ثقة كافية, وقد أجهد نفسه لفترة طويلة لكي يدرّبه, فأثار بذلك سخرية أهل الطيبة. ومن جملة ما فعله عساف في هذه الفترة, إضافة إلى المدة التي قضاها في البيت, أنه ربط الكلب بحبل وبدأ يتجول به في الأماكن القريبة, واشترى له كمية من (الحامض حلو), وحاول أن يعلمه عادات جديدة. والناس الذين رأوه يجرّ الكلب بالحبل ضحكوا طويلاً وأبدوا سخرية مريرة: - انظروا.. المجنون يربط كلب الصيد! - لا أحد يدري مَن يصيد لمَن, أو مَن يساعد مَن! لم يكتفوا بذلك وإنما انضموا إلى الذين اتهموه بسرقة الكلب, ولو لم يكن الأمر كذلك لما فعل ما يفعله الآن! - سبحان الخالق! ربما ولدتهما أُم واحدة . انظروا إنه يشبهه تمامًا. إن ذلك كله من تاريخ الطيبة الأقرب إلى النسيان. فبعد أن أصبح عساف والكلب متلازمين, بدت صورتا الاثنين واحدة, وتجرأ بعض الخبثاء, وقالوا إن هناك شبهًا قويًّا بين عساف والكلب, من حيث ضخامة الأنف وكبر الأذنين, ومن الصوت المكتوم الأقرب إلى الغرغرة. طبيعي لم يستطع أحد أن يقول هذا الكلام مباشرة لعساف, أو في أثناء وجوده, لكن أحدًا لا يسمِّي الكلب إلاَّ عسَّافا, ولا أحد ينظر إليه إلاَّ تلك النظرة! إن الطيبة مثل كل القرى والبلدان الأخرى التي تشبهها, من حيث القسوة والسخرية ورغبة التندر واختلاق بعض الأكاذيب, وفي اغتياب الناس أيضًا, خاصة إذا كان هؤلاء مثل عساف. إذ ما يكاد يظهر في غبش الصباح الأول ويراه أحد حتى يمتلئ وجه مَن يراه بابتسامة أقرب إلى السخرية, ويسأله تلك الأسئلة عن الصيد والكلب, وعن العجائب التي يراها في البرية! أمَّا إذا طالت السهرات وامتلأت بالأحاديث, فلا بدَّ أن يتبرع أحد ويقول شيئًا ساخرًا: - رأيت اليوم عسافًا يحمل الكلب على ظهره! ويقول آخر والضحكة تملأ حلقه: - رأيت اليوم عسافًا الحقيقي يحمل البندقية ويصيد.. ولا بدَّ أن يكون هو الصياد وليس هذا الكذوب. ويقول ثالث: - أطلق عساف النار على ديك حجل فلم يصبه, وأصاب الكلب, ولذلك فهو كلب أعور! إن شيئًا ما حصل في وقت من الأوقات, لكن طريقة الطيبة في نقل الأخبار تختلف عمَّا يجاورها, إذ لا بدَّ أن يكون في أي قصة يرويها أحد من أهل الطيبة مقدار من الصحة. فعين الكلب المطفأة كانت هكذا منذ اليوم الأول الذي وصل الكلب إلى الطيبة. وإذا كان عساف قبله هكذا ولم يسأل كيف عورت عينه أو متى, فقد قال ذات يوم إن ذلك ربما وقع في الصيد, ولم يضف شيئًا. أما الطيبة فروت ذلك على أنه وقع لعساف, ومع ذلك الكلب. وإذا كان عساف اضطر إلى حمل الكلب ذات مرة, فقد فعل ذلك بعد معركة مريرة بين كلبه وذئب, وكاد عساف ذاته يموت خلال تلك المعركة. أما الكلب فنُهش في أكثر من موضع, ولو تُرك لمات! أما حديث البندقية التي يزعم بعض أهل الطيبة أنه رأى الكلب يحملها ويصيد بها فلا أساس له البتة, وإنما هو وهم وحسد; لأنَّ الكلب, وبعد تدريب طويل, كان يساعد في حمل قسم من الصيد, كأن يحمل ديكًا من الحجل بين أسنانه! والطيبة التي تحب الفكاهة والسخرية, مثل غيرها من القرى, في أوقات الراحة والفرح, تتغير كثيرًا أيام الأحزان, وتتغير أكثر أيام تشحّ الأمطار وتأتي سنوات المُحْل. تصبح بلدة أقرب إلى السواد, تغطّيها الظلمة عند الغروب, وتمتد فوقها موجة من الصمت والأحزان, وتبدو لياليها طويلة ساكنة, عدا أصوات الكلاب المشرّدة الجائعة, وطلقات تائهة في بعض الأحيان. وفوق الطيبة, في مثل هذه الأيام, تنتشر رائحة ثقيلة منذرة, لكن لا يميز تلك الرائحة إلاَّ من عرفها أو تنشّقها ذات يوم! وفي هذه الأيام تتغيّر أشياء كثيرة! هذه السنة ليست مثل أي سنة سابقة. هكذا بدأت منذ الأيام الأولى للشتاء. فلم تهطل الأمطار المبكرة التي تنتظرها جميع القرى الواقعة على أطراف البادية, والتي تبشر بموسم خصب, وتحمل معها أعدادًا لا حصر لها من النباتات البرية, ويُقال إن تلك النباتات تنزل من السماء مع المطر. هذه السنة جاءت برياح باردة شديدة القسوة ولم تجئ بالأمطار. وأهل الطيبة الذين تعوّدوا على استقبال مثل هذه الشتاءات الباردة لم يستغربوا ولم يتبرموا, لأنهم ما زالوا في أوَّل الشتاء, ولأنَّ أيام الخير أمامهم لا تزال كثيرة وطويلة. لكن المسنّين الذين خبروا دورات الطبيعة, وعرفوا بشائر الخير من نذر القحط, دخل الخوف قلوبهم: كان خوفًا أقرب إلى الحزن, وارتفعت في ذاكرتهم أيام مثل هذه الأيام, ثم جاءت بعدها المصائب والأمراض وأخيرًا جاء الموت. ومع ذلك كتموا مشاعرهم في صدورهم وصمتوا. أمَّا الرجال الآخرون, الأصغر سنًّا والأقل دراية بالمواسم والطبيعة, فقد نظروا إلى السماء بتساؤل, وداخلهم الشك فيما يعرفون من أمور. وحين سألهم الصغار إن كان الكماء والفطر والحميض والخبيز وعشرات النباتات البرية الأخرى, ستأتي هذه السنة, نظروا إلى الصغار بارتياب, وكأنَّ مثل هذه الأسئلة تحمل لهم امتحانًا عسيرًا, واكتفوا بإجابات غامضة, أقرب إلى التحدي: - الشتاء في أوّله, وأنتم مرضى بشيء لم نعرفه عندما كنا في أعماركم. أنتم مرضى بالأسئلة التي لا جواب لها! والصغار الذين لم يكتفوا ولم يقتنعوا بإجابات الآباء, ذهبوا إلى الأمهات وأمطروهن بأسئلة لا تنتهي: (متى نذهب إلى التشوّل للفقع)?), (متى نذهب إلى الكماء?), (هل سنجد كميات كبيرة من الفطر هذه السنة, كما وجدناها في السنة الماضية?). وإذا كان الأبناء, في مثل هذه السن, لا يجرؤون على مناقشة الآباء أو الإلحاح بسؤالهم, فإنَّهم على الأمهات أكثر جرأة وأكثر إلحاحًا, والأمهات بطريقة غامضة, وتتميّز بمكر خفي, يحاولن بكل الوسائل أن يصرفن الأبناء عن مثل هذه الأسئلة, لكن الوعود تبقي قائمة, والرؤوس تشتعل بعشرات الرغبات والأحلام. أما إذا نظرت النسوة في وجوه الرجال, خاصة المسنين, فكنَّ يقرأن في تلك الوجوه مصاعب الأيام القادمة وآلامها التي لا يمكن أن تُنسى! هكذا بدأ الشتاء في هذه السنة. وإذن كان كل يوم يأتي ولا يأتي المطر, يحمل معه مزيدًا من العصبية للذين يذهبون إلى الحقول, وينظرون إليها بحزن, وقد تحجّرت التربة من البرودة, وعبثت بها العصافير الموسمية التي تأتي بأعداد كبيرة وتخلق في الجو دويًّا لا ينقطع منذ الفجر وحتى الغروب, ولا ترهب هذه العصافير الفزاعات السوداء التي تُنصب في أماكن عديدة من الحقول. إن كل يوم يمر يحمل نذيرًا جديدًا, ويضيف خوفًا جديدًا في قلوب الرجال, وهمًّا ثقيلاً أقرب إلى الحزن في قلوب النساء. أما حين يعصف الجو وتعربد الرياح الباردة, فإنَّ انتظارًا ممضًّا يشبه حد الموسى يسيطر على البلدة: (هل ستحمل هذه الرياح المطر? هل سينبت الزرع بعد هذا الجفاف الطويل? وإذا جاءت قطرة أو قطرتان, فمَن يضمن المطر في آذار ونيسان?). وتهوّم في الرؤوس أسئلة من نوع آخر: (ما دام الموسم قد انتهى, فقد كان على الله أن يبعث لنا بالأمطار الموسمية المبكرة. لو جاءت تلك الأمطار لأخرجت لنا البرية شيئًا نأكله ويعوضنا عن التعب والموت, لكن الموسم انتهى, وآذار لم تبقَ فيه إلاَّ أيام وينقضي دون قطرة مطر, ولا أحد يعرف كيف ستكون الحياة بعد ذلك!). وفي نهاية آذار تمامًا هطل المطر. كان مطرًا غزيرًا استمر يومين متواليين. وخلال هذين اليومين تغيّرت وجوه الناس وتصرفاتهم, حتى الذين لا علاقة لهم بالزراعة مباشرة بدوا أكثر فرحًا, وفي بعض الأحيان أقرب إلى الخفة في التعبير عن ذلك الفرح, وتجرأ الكثيرون وقالوا: (موسم هذه السنة, خاصة بالنسبة للصيفي, سيكون أحسن من جميع المواسم التي شهدناها من قبل). لكن الذين يزرعون, والذين عرفوا دورات الطبيعة, لم يتكلموا ولم يتفاءلوا, كانوا ينتظرون شيئًا آخر. وفي هذه الأيام, وبعد أن أشرقت الشمس وملأت الكون في اليوم الثالث, ما لبث الذين امتنعوا عن الزرع في بداية الموسم, أن حرثوا الأرض على عجل, واستعانوا بكل الوسائل, لكي يضمنوا لأنفسهم زرعًا وفيرًا مثل غيرهم! لكن مطر آذار بغزارته وجنونه لا يمكن أن يقنع المسنّين ولا يرضيهم. إن لهؤلاء مزاجًا يختلف عن غيرهم, وهذا المزاج ربما كوّنته الطبيعة والأيام الطويلة والمخاوف, وربما يتولّد لأسباب غامضة مجهولة! وقد تكون له علاقة بالأرض ذاتها, إذ يشعر أي واحد من هؤلاء بأن كل يوم جديد يقرّبه أكثر فأكثر من الأرض. وما دام الأمر هكذا, فإنَّ أمنية خفية تدفعه لأن يتمنى أرضًا من نوع ما يمكن أن تستقبل لحمه وعظامه, ويحس بنفس الخفاء أن هذا الجفاف الذي تسرّب عميقًا إلى الأرض, ثم تلك الرخاوة اللزجة التي جاء بها مطر آذار, لا يناسبان, ويتمنى لو أنه لا يغادر الحياة في مثل السنة القاسية. وحتى لو بلغ اليأس مبلغًا كبيرًا في قلوب المسنّين وأصابهم الغمّ والسأم من هذه الدورة العاتية للطبيعة, فقد كان كل واحد منهم يريد أن يموت موتًا كريمًا لائقًا, أن يموت في الوقت الذي أنهي كل ما يجب أن يفعله في هذه الحياة, وأن يغادر الدنيا بهدوء وسلام, دون جلبة, ولكن باحترام يناسب عمره. أما أن يموت مثلما يموت الصغار, أو مثلما تموت الدواب, بطريقة مفاجئة, ودون إنذار من أي نوع, فإن موتًا مثل هذا يدفعه إلى شعور عميق باليأس! يتبع،،،، |

|
|
|
#12 |
|
تميراوي
|
هكذا تعوَّد أهل الطيبة على عساف, ونتيجة الألفة والاستمرار, لم يعد يثير تساؤلاً أو استنكارًا. الشيء الوحيد الذي أثار اهتمام الناس ذات يوم, ولم يستمر هذا الشيء طويلاً, أن عسافًا اقتنى كلبًا. ولقد بالغ كثيرًا, حين سئل عن الكلب, في الحديث عن أهميته وأصله, وبالغ أكثر من ذلك في تحديد المبلغ الذي دفعه ثمنًا له. وقد قيل مرات كثيرة إن عسافًا وجد الكلب ضائعًا, ربما من صياد غريب, فجاء به. وتجرأ بعض الناس في الطيبة وقال إن عسافًا سرقه! وعساف الذي سمع بعض ما يقوله الناس, كان يبتسم دون اهتمام, ويطبطب على ظهر الكلب بمودة, ويقول له: (اسمع ما يقول الهبل). وخلال هذه الفترة قضى عساف وقتًا أطول مما تعوَّد في البيت, وقضى بعد ذلك أسبوعين في الطيبة, لم يخرج خلالهما إلى الصيد. وقد فسّر الأمر بالخوف . فالذين قالوا إنه سرق الكلب, كانوا متأكدين من ذلك أكثر من ذي قبل, لأن الأمر لو كان له سبب آخر لما خشي عساف الخروج إلى الصيد واصطحاب كلبه معه. أمَّا الذين قالوا إن عسافًا وجده, فقد كانوا على يقين أن الكلب سيعود إلى أصحابه حالما يخرج من الدار ويصبح حرًّا, ولن يستطيع عساف أن يفعل شيئًا لو هرب الكلب وعاد إلى أصحابه! أما الحقيقة فهي أن عسافًا لا يثق إلاَّ بما يفعله, ولا يتأكد إلاَّ إذا فعل الشيء بنفسه, ولذلك, وبعد أن رافق صيادين جاءوا إلى الطيبة من مكان بعيد, ونتيجة للجهد الذي بذله معهم, ولأنه دلّهم على أماكن مناسبة للحجل, ثم تنازل لهم عن الطيور الخمسة التي اصطادها, أعطوه ذلك الكلب. لكن عسافًا لم يكن واثقًا بالكلب ثقة كافية, وقد أجهد نفسه لفترة طويلة لكي يدرّبه, فأثار بذلك سخرية أهل الطيبة. ومن جملة ما فعله عساف في هذه الفترة, إضافة إلى المدة التي قضاها في البيت, أنه ربط الكلب بحبل وبدأ يتجول به في الأماكن القريبة, واشترى له كمية من (الحامض حلو), وحاول أن يعلمه عادات جديدة. والناس الذين رأوه يجرّ الكلب بالحبل ضحكوا طويلاً وأبدوا سخرية مريرة: - انظروا.. المجنون يربط كلب الصيد! - لا أحد يدري مَن يصيد لمَن, أو مَن يساعد مَن! لم يكتفوا بذلك وإنما انضموا إلى الذين اتهموه بسرقة الكلب, ولو لم يكن الأمر كذلك لما فعل ما يفعله الآن! - سبحان الخالق! ربما ولدتهما أُم واحدة . انظروا إنه يشبهه تمامًا. إن ذلك كله من تاريخ الطيبة الأقرب إلى النسيان. فبعد أن أصبح عساف والكلب متلازمين, بدت صورتا الاثنين واحدة, وتجرأ بعض الخبثاء, وقالوا إن هناك شبهًا قويًّا بين عساف والكلب, من حيث ضخامة الأنف وكبر الأذنين, ومن الصوت المكتوم الأقرب إلى الغرغرة. طبيعي لم يستطع أحد أن يقول هذا الكلام مباشرة لعساف, أو في أثناء وجوده, لكن أحدًا لا يسمِّي الكلب إلاَّ عسَّافا, ولا أحد ينظر إليه إلاَّ تلك النظرة! إن الطيبة مثل كل القرى والبلدان الأخرى التي تشبهها, من حيث القسوة والسخرية ورغبة التندر واختلاق بعض الأكاذيب, وفي اغتياب الناس أيضًا, خاصة إذا كان هؤلاء مثل عساف. إذ ما يكاد يظهر في غبش الصباح الأول ويراه أحد حتى يمتلئ وجه مَن يراه بابتسامة أقرب إلى السخرية, ويسأله تلك الأسئلة عن الصيد والكلب, وعن العجائب التي يراها في البرية! أمَّا إذا طالت السهرات وامتلأت بالأحاديث, فلا بدَّ أن يتبرع أحد ويقول شيئًا ساخرًا: رأيت اليوم عسافًا يحمل الكلب على ظهره! ويقول آخر والضحكة تملأ حلقه: - رأيت اليوم عسافًا الحقيقي يحمل البندقية ويصيد.. ولا بدَّ أن يكون هو الصياد وليس هذا الكذوب. ويقول ثالث: - أطلق عساف النار على ديك حجل فلم يصبه, وأصاب الكلب, ولذلك فهو كلب أعور! إن شيئًا ما حصل في وقت من الأوقات, لكن طريقة الطيبة في نقل الأخبار تختلف عمَّا يجاورها, إذ لا بدَّ أن يكون في أي قصة يرويها أحد من أهل الطيبة مقدار من الصحة. فعين الكلب المطفأة كانت هكذا منذ اليوم الأول الذي وصل الكلب إلى الطيبة. وإذا كان عساف قبله هكذا ولم يسأل كيف عورت عينه أو متى, فقد قال ذات يوم إن ذلك ربما وقع في الصيد, ولم يضف شيئًا. أما الطيبة فروت ذلك على أنه وقع لعساف, ومع ذلك الكلب. وإذا كان عساف اضطر إلى حمل الكلب ذات مرة, فقد فعل ذلك بعد معركة مريرة بين كلبه وذئب, وكاد عساف ذاته يموت خلال تلك المعركة. أما الكلب فنُهش في أكثر من موضع, ولو تُرك لمات! أما حديث البندقية التي يزعم بعض أهل الطيبة أنه رأى الكلب يحملها ويصيد بها فلا أساس له البتة, وإنما هو وهم وحسد; لأنَّ الكلب, وبعد تدريب طويل, كان يساعد في حمل قسم من الصيد, كأن يحمل ديكًا من الحجل بين أسنانه! والطيبة التي تحب الفكاهة والسخرية, مثل غيرها من القرى, في أوقات الراحة والفرح, تتغير كثيرًا أيام الأحزان, وتتغير أكثر أيام تشحّ الأمطار وتأتي سنوات المُحْل. تصبح بلدة أقرب إلى السواد, تغطّيها الظلمة عند الغروب, وتمتد فوقها موجة من الصمت والأحزان, وتبدو لياليها طويلة ساكنة, عدا أصوات الكلاب المشرّدة الجائعة, وطلقات تائهة في بعض الأحيان. وفوق الطيبة, في مثل هذه الأيام, تنتشر رائحة ثقيلة منذرة, لكن لا يميز تلك الرائحة إلاَّ من عرفها أو تنشّقها ذات يوم! وفي هذه الأيام تتغيّر أشياء كثيرة! هذه السنة ليست مثل أي سنة سابقة. هكذا بدأت منذ الأيام الأولى للشتاء. فلم تهطل الأمطار المبكرة التي تنتظرها جميع القرى الواقعة على أطراف البادية, والتي تبشر بموسم خصب, وتحمل معها أعدادًا لا حصر لها من النباتات البرية, ويُقال إن تلك النباتات تنزل من السماء مع المطر. هذه السنة جاءت برياح باردة شديدة القسوة ولم تجئ بالأمطار. وأهل الطيبة الذين تعوّدوا على استقبال مثل هذه الشتاءات الباردة لم يستغربوا ولم يتبرموا, لأنهم ما زالوا في أوَّل الشتاء, ولأنَّ أيام الخير أمامهم لا تزال كثيرة وطويلة. لكن المسنّين الذين خبروا دورات الطبيعة, وعرفوا بشائر الخير من نذر القحط, دخل الخوف قلوبهم: كان خوفًا أقرب إلى الحزن, وارتفعت في ذاكرتهم أيام مثل هذه الأيام, ثم جاءت بعدها المصائب والأمراض وأخيرًا جاء الموت. ومع ذلك كتموا مشاعرهم في صدورهم وصمتوا. أمَّا الرجال الآخرون, الأصغر سنًّا والأقل دراية بالمواسم والطبيعة, فقد نظروا إلى السماء بتساؤل, وداخلهم الشك فيما يعرفون من أمور. وحين سألهم الصغار إن كان الكماء والفطر والحميض والخبيز وعشرات النباتات البرية الأخرى, ستأتي هذه السنة, نظروا إلى الصغار بارتياب, وكأنَّ مثل هذه الأسئلة تحمل لهم امتحانًا عسيرًا, واكتفوا بإجابات غامضة, أقرب إلى التحدي: - الشتاء في أوّله, وأنتم مرضى بشيء لم نعرفه عندما كنا في أعماركم. أنتم مرضى بالأسئلة التي لا جواب لها! والصغار الذين لم يكتفوا ولم يقتنعوا بإجابات الآباء, ذهبوا إلى الأمهات وأمطروهن بأسئلة لا تنتهي: (متى نذهب إلى التشوّل للفقع)?), (متى نذهب إلى الكماء?), (هل سنجد كميات كبيرة من الفطر هذه السنة, كما وجدناها في السنة الماضية?). وإذا كان الأبناء, في مثل هذه السن, لا يجرؤون على مناقشة الآباء أو الإلحاح بسؤالهم, فإنَّهم على الأمهات أكثر جرأة وأكثر إلحاحًا, والأمهات بطريقة غامضة, وتتميّز بمكر خفي, يحاولن بكل الوسائل أن يصرفن الأبناء عن مثل هذه الأسئلة, لكن الوعود تبقي قائمة, والرؤوس تشتعل بعشرات الرغبات والأحلام. أما إذا نظرت النسوة في وجوه الرجال, خاصة المسنين, فكنَّ يقرأن في تلك الوجوه مصاعب الأيام القادمة وآلامها التي لا يمكن أن تُنسى! هكذا بدأ الشتاء في هذه السنة. وإذن كان كل يوم يأتي ولا يأتي المطر, يحمل معه مزيدًا من العصبية للذين يذهبون إلى الحقول, وينظرون إليها بحزن, وقد تحجّرت التربة من البرودة, وعبثت بها العصافير الموسمية التي تأتي بأعداد كبيرة وتخلق في الجو دويًّا لا ينقطع منذ الفجر وحتى الغروب, ولا ترهب هذه العصافير الفزاعات السوداء التي تُنصب في أماكن عديدة من الحقول. إن كل يوم يمر يحمل نذيرًا جديدًا, ويضيف خوفًا جديدًا في قلوب الرجال, وهمًّا ثقيلاً أقرب إلى الحزن في قلوب النساء. أما حين يعصف الجو وتعربد الرياح الباردة, فإنَّ انتظارًا ممضًّا يشبه حد الموسى يسيطر على البلدة: (هل ستحمل هذه الرياح المطر? هل سينبت الزرع بعد هذا الجفاف الطويل? وإذا جاءت قطرة أو قطرتان, فمَن يضمن المطر في آذار ونيسان?). وتهوّم في الرؤوس أسئلة من نوع آخر: (ما دام الموسم قد انتهى, فقد كان على الله أن يبعث لنا بالأمطار الموسمية المبكرة. لو جاءت تلك الأمطار لأخرجت لنا البرية شيئًا نأكله ويعوضنا عن التعب والموت, لكن الموسم انتهى, وآذار لم تبقَ فيه إلاَّ أيام وينقضي دون قطرة مطر, ولا أحد يعرف كيف ستكون الحياة بعد ذلك!). وفي نهاية آذار تمامًا هطل المطر. كان مطرًا غزيرًا استمر يومين متواليين. وخلال هذين اليومين تغيّرت وجوه الناس وتصرفاتهم, حتى الذين لا علاقة لهم بالزراعة مباشرة بدوا أكثر فرحًا, وفي بعض الأحيان أقرب إلى الخفة في التعبير عن ذلك الفرح, وتجرأ الكثيرون وقالوا: (موسم هذه السنة, خاصة بالنسبة للصيفي, سيكون أحسن من جميع المواسم التي شهدناها من قبل). لكن الذين يزرعون, والذين عرفوا دورات الطبيعة, لم يتكلموا ولم يتفاءلوا, كانوا ينتظرون شيئًا آخر. وفي هذه الأيام, وبعد أن أشرقت الشمس وملأت الكون في اليوم الثالث, ما لبث الذين امتنعوا عن الزرع في بداية الموسم, أن حرثوا الأرض على عجل, واستعانوا بكل الوسائل, لكي يضمنوا لأنفسهم زرعًا وفيرًا مثل غيرهم! لكن مطر آذار بغزارته وجنونه لا يمكن أن يقنع المسنّين ولا يرضيهم. إن لهؤلاء مزاجًا يختلف عن غيرهم, وهذا المزاج ربما كوّنته الطبيعة والأيام الطويلة والمخاوف, وربما يتولّد لأسباب غامضة مجهولة! وقد تكون له علاقة بالأرض ذاتها, إذ يشعر أي واحد من هؤلاء بأن كل يوم جديد يقرّبه أكثر فأكثر من الأرض. وما دام الأمر هكذا, فإنَّ أمنية خفية تدفعه لأن يتمنى أرضًا من نوع ما يمكن أن تستقبل لحمه وعظامه, ويحس بنفس الخفاء أن هذا الجفاف الذي تسرّب عميقًا إلى الأرض, ثم تلك الرخاوة اللزجة التي جاء بها مطر آذار, لا يناسبان, ويتمنى لو أنه لا يغادر الحياة في مثل السنة القاسية. وحتى لو بلغ اليأس مبلغًا كبيرًا في قلوب المسنّين وأصابهم الغمّ والسأم من هذه الدورة العاتية للطبيعة, فقد كان كل واحد منهم يريد أن يموت موتًا كريمًا لائقًا, أن يموت في الوقت الذي أنهي كل ما يجب أن يفعله في هذه الحياة, وأن يغادر الدنيا بهدوء وسلام, دون جلبة, ولكن باحترام يناسب عمره. أما أن يموت مثلما يموت الصغار, أو مثلما تموت الدواب, بطريقة مفاجئة, ودون إنذار من أي نوع, فإن موتًا مثل هذا يدفعه إلى شعور عميق باليأس! يتبع،،،، |

|
|
|
#13 |
|
تميراوي
|
ومثلما توقّع المسنّون حصلت الأمور بعد ذلك: فالزرع الذي اهتزَّ في أعماق التربة من الأمطار الغزيرة التي سقطت في نهاية آذار, ما لبث أن شقَّ الأرض وبدأ ينمو. كانت الزروع بنموّها الزاهي, رغم المسافات المتباعدة فيما بينها, نتيجة لهجوم العصافير وتقليب المحاريث, كانت بنموها قوية واثقة, وما كادت شمس نيسان تحتضنها بالدفء حتى انتعشت وتحرّكت أكثر من قبل. وإذا كان الفلاحون, بتفاؤل موهوم, يردّدون بإصرار أن ما يحتاجون إليه مطرة أو مطرتين في نيسان, الأولى في النصف الأول, والثانية في نهايته, ثم مطرة أخيرة في منتصف أيار, رغم هذا التفاؤل الذي يحاولون من خلاله أن يقنعوا أنفسهم قبل أن يقنعوا غيرهم, فقد كانت مثل هذه الأمنيات مستحيلة, لأن السنة من بدايتها كانت تنذر بالقحط. قال هذا المسنّون في داخلهم, وقال هذا عساف بصوت عال وأمام جميع الناس. ولو أن أحدًا سأل عسافًا عن السبب الذي يدعوه لأن يقول مثل هذا القول, لم يكن يملك جوابًا واضحًا أو مقنعًا. كان يكتفي بأن يقول: - انتظروا, هذا ما أقوله, وسوف ترون كل شيء بعيونكم! والناس حين يسمعون هذا الكلام من عساف تتملكهم العصبية ويصبحون سريعي الغضب, وأقرب إلى التحدِّي, لكن في قرارة أنفسهم يحسون أن ما يقوله هذا المجنون لا يشبه الكلام الذي يقوله غيره. إن فيه شيئًا من الحقيقة, حقيقة خفية غامضة, وربما مرتبطة بأمر لا يعرفونه. ومثلما أحسَّ المسنّون, ثم توقعوا, بدأت كلمات التحذير تتسرب من أفواههم, ثم كلمات الخوف, وفي وقت لاحق قالوا بوضوح شديد: - ستكون هذه السنة من أصعب السنين التي مرّت على الطيبة! وبعد لحظات من التفكير والتذكر الحزين يضيف أحد المسنّين: - لا أتذكر أن سنة مثل هذه مرّت على الطيبة من قبل. ومثلما توقع المسنّون, ومثلما قال عساف حصل كل شيء بعد ذلك! في هذا الغمّ الذي يلفّ الطيبة من كل جوانبها, ويزداد يومًا بعد آخر, كان عساف لا يهدأ ولا يستريح, إذ ما يكاد يعود بعد الغروب, حاملاً معه عشرات الطيور, حتى يبدأ يدقّ بعض الأبواب. كان يختار تلك الأبواب بعناية, ويفكّر في ذلك من قبل طويلاً. كان مع كل طلقة ينوي حتى قبل سقوط الطير: (أنت لأُم صبري), (وأنت لداود الأعمى), (وأنت لسعيد الذي لا يتقن في هذه الدنيا سوى إنجاب البنات)! هكذا كان يفعل وهو يطارد الطيور. وحين يدق الأبواب, ولكي لا يخلق ذلك الخوف الغامض المتربص في كل القلوب, والذي يعلن عن نهاية صديق أو قريب, كانت الكلمات التي يطلقها عساف في الهواء وقبل أن يفتح له الباب: - أنا عساف, جئت لأمسي عليكم! وقبل أن يسمع الكلمات التي تنهال عليه, يكون قد ألقى بعض الطيور ومشى! كان يفعل ذلك كل ليلة, ولا يبقي لنفسه إلاَّ طيرًا, وفي بعض الأحيان لا يبقي شيئًا. وحالما ينتهي من هذه المهمة, وعلى ضوء فانوس صغير يبدأ بتحضير خرطوش اليوم التالي. يبدأ مهمة لا تعرف التعب أو التوقف, ولا يكاد يأكل لقمة في نهاية السهرة حتى يغط في نوم عميق. وفي هذا النوم يرى أحلامًا لا حصر لها, كانت تتراءى له آلاف الصور: كيف كانت الطيبة وكيف هي الآن?! ويسأل نفسه: لماذا تصبح الحياة أكثر صعوبة يومًا بعد آخر?! أما حين تظهر له صور الأشجار والطيور, ثم صورة الماء الجاري دون توقف, وصورة الربيع يغطي مساحات لا نهاية لها, فكان يرى كل شيء يطير. كانت السماء تمتلىء بالطيور, وكان الصيادون لا يصيدون إلاَّ في المواسم والطيور التي يجب أن تُصاد. ثم تظهر له صور الذين ماتوا, أمَّا حين يبدأ المطر بالسقوط ويخاف أن توحل الأرض وتمنعه من العودة فكان يركض, وعند ذلك يفزع ويستيقظ من نومه وقد امتلأ خوفًا أن يكون الوقت قد فاته. وحين يحس برائحة الغبار تملأ جو الغرفة يفرك عينيه لكي يتأكّد من الوقت. كانت له ساعة في داخله لا تخطئ. لم تخطئ مرة واحدة طوال هذه السنين, لا تخطئ في الصيف ولا في الشتاء. حتى الذين كانوا يأتون إلى الطيبة من المدينة, ويستعدون كثيرًا من أجل رحلة الصيد مع عساف, وينصبون الساعات المنبّهة, ويصدرون الأوامر الصارمة إلى المسنّين لكي يوقظوهم في الوقت المناسب, لئلا يتركهم عساف ويمشي, بحجة أن الشمس ستشرق ويضيع اليوم, ولكي يكونوا في (المقوس) عند الشروق, حتى هؤلاء كانوا يخطئون وعساف لا يخطئ ولا تخطئ ساعته! وعساف الذي تعوّد خلال فترة طويلة أن يخرج إلى الصيد وحيدًا مع كلبه, كان يجد صعوبة في أن يردّ الذين يطلبون الخروج معه, خاصة من الضيوف, أو في سنة من سنوات القحط. كان يتمنى لو يبقي وحيدًا, لكن ماذا يستطيع أن يفعل وقد أمْحلت الأرض وابتعدت الغيوم ولم يعد عند الناس شيء يأكلونه? حتى أماكن الصيد التي خبأها لنفسه في فترات سابقة, وكان يردّد لنفسه بإصرار أنه لن يترك أحدًا يصِلها, ولن يدل أحدًا عليها, لا يستطيع أن يمتنع طويلاً في إخفائها, لكن كان ينبه بتأكيد حازم: - لا تقتلوا الإناث, إنَّها رزقنا الباقي! وحين لا يكون متأكدًا أنهم فهموا جيدًا يضيف: - الإناث, إناث الحجل, صغيرة ولونها واضح. أما إذا سألوه مزيدًا من التوضيح والمعلومات فكان يقول: - ديك الحجل, مثل بعض الرجال, جبان. وينظر في وجوههم ويضحك, ثم يتابع: - إنه يخاف على نفسه كثيرًا, وهو بلون زاهٍ, ملوَّن أكثر من الأنثى, ويطير قبلها! ويهزّون رؤوسهم دلالة المعرفة, لكن عسافًا يخاف هؤلاء الصيّادين, ويكره الجبناء والخبثاء منهم, ويخاف أكثر من ذلك أن يأتي يوم لا تجد الطيبة طيرًا تصيده. كان يقول بصوت ملئ بالأسى: - هذه الطيور لنا, اليوم أو غدًا, وستبقي لنا إذا حافظنا عليها. أما إذا قتلناها كلها, إذا طاردناها كثيرًا, فسوف تنتهي أو تبحث عن مكان آخر. ويصرخ بعصبية وقد تراءت له الأرض خالية تمامًا من طيور الحجل: - اسمعوا, إذا انتهت هذه الطيور وجاءت سنة من سنوات المحل, وإذا ظلَّت الحكومة تكذب سنة بعد سنة ولا تبني السدّ, فتأكّدوا أن أهل الطيبة سيموتون على بكرة أبيهم. أنا متأكد من ذلك, فهل يستطيع ابن حرّة أن يقتل البشر والطيور? هكذا كان الحديث يجري في بداية كل رحلة. ورغم ذلك يضطر عساف لقيادة قافلة الصيادين إلى أماكن الحجل, لكنه يلجأ إلى المكر أغلب الأحيان: كان يقودهم إلى الأماكن الصعبة, إلى الأماكن البعيدة والخطرة, وكان يعرف أن التعب أو الخوف إذا دخل قلب الصياد يفقده كثيرًا من قسوته ويجعله رحيمًا. هكذا كان يفعل في بداية الموسم. أما إذا قست الحياة على الطيبة أكثر من قبل وحاصرها الجوع وبدأ يفتك بها, فكان يتردّد في أن يتجاوز كثيرًا من القيود التي كان يفرضها على نفسه وعلى الآخرين, لكنه يتألم, يشتعل بالشتائم ويرتكب الكثير من الحماقات. كان يقول لنفسه لكي يبرّر هذه الخطيئة التي تعذّبه: (إذا لم يأكل الناس الحجل فسوف تأكله بنات آوى والذئاب, وحتى لو نجا بعض هذه المخلوقات الملعونة, فسوف يأتي الرعيان لكي يلتقطوا البيض. ويجب ألاّ يموت أهل الطيبة). إن له فلسفة خاصة تكوّنت مع الأيام ومن التجارب, حتى لو أراد أن يقول بضع كلمات لكي يفسر ما يدور في عقله فلن يستطيع. أما إذا سأله أحد لماذا يفعل هذا الشيء, ولماذا لا يفعل ذاك, فكان يشعر بالحيرة والعجز. كان يقول: - هذه هي طريقة الصيد, هكذا يفعل الصياد! ولا يضيف شيئًا آخر! بهذه الطريقة كان يتعامل مع الصيد, وبهذه الفلسفة الغامضة يتصرف, ويريد من الآخرين أن يتصرفوا. فإذا جاء موسم الطيور المهاجرة يشعر بغبطة داخلية عميقة. كان يقول بصوت عال واضح النبرات, ويريد من كل إنسان أن يسمعه: - ليشمّر كل واحد منكم عن زنده, وليثبت الصياد نفسه! كان يقول مثل هذا الكلام لكي يضلِّل الصيادين الآخرين ويصرفهم عن الحجل. وهؤلاء الصيادون الذين تعبوا كثيرًا من الحجل, وحفيت أقدامهم وهم يتسلقون الصخور العالية أو وهم يهبطون الأودية السحيقة, كانوا في قرارة أنفسهم يقبلون هذا الكلام ويوافقون عليه, وفي نطاق التبرير يقولون لأنفسهم ولبعضهم: - ما دام شيخ الصيادين, عساف, يقول هذا فيجب أن نصدّقه وأن نتبعه! وكي لا يترك الأمر مكرًا مجردًا, كان يسبقهم يتبع،،،، |

|
|
|
#14 |
|
تميراوي
|
إلى أماكن الطيور المهاجرة وممراتها, وكان لا يبخل عليهم بأي معلومات تساعدهم وتمكّنهم من صيد أوفر. وهم بتقدير غامض يندفعون, يذهبون حيث يريد, إلى الأماكن التي يحددها وفي الأوقات التي يحدّدها. بهذه الطريقة يضمن أن بعض طيور الحجل لا تزال حية في المعاصي. كان يقول لنفسه بثقة: (حالما تشعر بالأمن وبابتعاد أصوات الطلقات لا بدَّ أن تنزل إلى أماكنها وتعيش مرة أخرى بسلام. ومرة أخرى ستفقس وتبدأ الفروخ الجديدة تملأ الجبال والوديان)! صحيح أن عسافًا في أعماقه يدرك أن كل حيوان وكل طير يعرف كيف يدافع عن نفسه وإلى أين يذهب, إلاَّ أنه حين يرى الصيادين الأغرار يزدادون قسوة ورعونة, ويخرقون كل قاعدة, كان يقول لنفسه بألم: (يقتلون الناس بهذه الطريقة. والحجل يعرف كيف يختفي ). ويضيف بعد فترة صمت طويلة: (حين طاردوا الغزلان وقتلوها كلها أصبحت الصحراء مثل قبر كبير, لا ترسل إلاَّ الغبار والموت, ويجب أن يكون أهل الطيبة أذكى من غيرهم فلا يقتلوا كل شيء). كان الحجل, في مثل هذه السنين, وبغريزة غامضة, حتى بالنسبة لعساف نفسه, يعرف كيف يختفي , حتى ليبدو وكأنه انقرض نهائيًّا, ولن يأتي شروق أو غروب في يوم من الأيام القادمة ويسمع صوته مثل دجاجات تائهة في سفوح الجبال الشرقية. عند ذاك كان الصيادون, حتى الأغرار العنيدون, يتحولون. والذي يساعد كثيرًا في هذا التحول المفاجئ أن طيور الصحراء, خصوصًا القطا, تبدأ بالاقتراب يومًا بعد آخر من الطيبة, وباندفاعها الأرعن بحثًا عن الحب والماء تعرّض نفسها للهلاك, حتى الأولاد الصغار, في أوقات معينة, وبتلك الوسائل البدائية التي يملكونها, يستطيعون الاحتيال عليها واصطياد عدد منها! لكن تبقي قوة الحياة هي الأقوى, إذ يتحول القطا, هذا الطائر الإبله, شيئًا فشيئًا إلى طائر جنّي, وبرغم الجوع والعطش فإنَّ قوة أخرى تسيطر عليه وتوجهه. فالقطا الطائش الذي يمكن أن يقتل بالعشرات والمئات في بداية الموسم, والذي لا يميز الصياد من الفلاح, لا يلبث أن يصبح طيرًا حذرًا. والصيادون الذين يبدون نوعًا من الترفع في بداية الموسم, ويصفون القطا بعشرات الأوصاف الرديئة, يصفونه بقسوة لحمه وغبائه, وبانعدام اللذة نهائيًّا في صيده, حتى هؤلاء يجدون أنفسهم يومًا بعد آخر وقد انساقوا إلى ملاحقته. وفي هذه الفترة, ولتبرير هذا السلوك, يقولون بصوت عال فيه تلك الكبرياء التي تميّز الصيادين المغرورين: - ضُرب وتنكّح, وأصبح أكثر حذرًا من الطيور الأخرى. ويضيف بعض هؤلاء بثقة كبيرة: - إن صيده الآن أصعب من صيد الحجل! هكذا تبدأ الدورة تتغير. والطيبة التي تعيش أيامًا صعبة مريرة, وتبحث عن طريقة لتواصل الحياة, تتغاضى عن أشياء كثيرة, بما فيها رعونة الشباب واندفاعهم إلى الصيد بهوس لم يتعوده أحد ولم يكن يميزهم من قبل. - هذا الجنون الذي يملأ عقولكم لا بدَّ أن يقضي على الصيد كله. وبكلمات قاسية, وفيها ذلك النزق الذي يميزه, يضيف: - الأيام الصعبة لم تأتِ بعد, وعلينا أن نستعد لتلك الأيام! فإذا سمع كلمات السخرية والتحدي, وإذا اتهموه أنه يريد التهرب, كان بانفعال يجيب: - إذا وفّرتم الخرطوش, إذا كنتم أكثر عقلاً وصبرًا, فالقطا سيصل إليكم, ولن تحتاجوا لأن تذهبوا إليه! لكن الشباب لا يسمعون, وتظل دوافع مشؤومة وقوية تدفعهم لأن ينتقموا, لأن يتباروا. وتحديات مثل هذه تدفع الطيبة ثمنها. فالطيور التي كانت تهجم برعونة في بداية الموسم, لا يلبث الخوف أن يتملكها, وتبدأ البحث عن أماكن أخرى, أو تغير مواعيد مجيئها وهربها. بكلمة; تغيِّر هذه الطيور طريقة حياتها, وتصبح الحياة لكل مخلوق أكثر قسوة وأكثر صعوبة. حتى عساف نفسه, الذي كان يعود بأعداد وفيرة من الطيور, يبدأ يواجه الصعوبة نفسها التي يواجهها الصيادون الأغرار, ويبدأ صيده يقل, ويصبح الصيد عملاً مضنيًا وأقرب إلى المغامرة. لكن عسافًا لا يهدأ ولا يتوقف! بدأت إذن الأيام الصعبة القاسية. ومثلما اختارت الطيبة أن تكون في هذا الموقع من العالم, على أطراف البادية, فقد اختارت الصيد والشجاعة, وعرفت كيف تتحمَّل كل ما يواجهها من مكاره وصعاب. وإذا كانت المجاعات تفرّق عادة بين الناس, وتجعل كل إنسان يبحث لنفسه عن طريقة يؤمِّن بها خبزه, فإنَّ المجاعات والأحزان تقرِّب بين الناس في الطيبة, وتجعلهم أُسرة واحدة وجسدًا واحدًا. وما عدا تلك الفئة الصغيرة التي جاءت من مكان بعيد, واختارت الطيبة سكنًا لها, وظلَّت تعمل وتتصرف بروح الغرباء وخوفهم, رغم ما قدَّم لها أهل الطيبة, فإنَّ البشر إذا واجهوا المصاعب بروح من التعاون والمشاركة, تبدو هذه المصاعب أقل قسوة, ويمكن التغلُّب عليها. وبهذه الطريقة الفذة المليئة بالبطولة الصامتة, لم يترك أحد يموت دون أن تقدم إليه أقصى المعونات, وأغلب الأحيان بشكل خفي لا يدركه أحد. فالأُسر الكبيرة العدد, والتي لا تقوي على مواجهة الحياة, كانت تفتح أبواب بيوتها, في ساعة من ساعات الليل أو النهار, ويُرمى داخلها بكمية من الحنطة أو قليل من السكر والشاي والصابون. والناس الذين فقدوا كل ما يملكون ثمنًا للبذار, ثم ثمنًا لبعض الأشياء التي اشتروها من المدينة, كان هؤلاء يجدون مساعدة لا تيسر للذين هم أكثر قدرة منهم. حتى المقعدون وذوو العاهات, قد تكفَّل بهم عدد من الشباب, وكانوا يقدّمون لهم الأكل المطبوخ, وغالبًا ما يكون حساء من الطيور أو الهريسة. أمَّا النساء الأرامل فقد كنَّ في هذه الفترة موضع رعاية كبيرة. لكن الطيبة التي تستطيع أن تطعم أبناءها أجزاء من لحمها لا تقوي على مواجهة مثل هذه المصائب سنة بعد أخرى بصدرها المكشوف وإمكاناتها المحدودة. وبرغم أن المسنِّين حذّروا كثيرًا من الإسراف, وطلبوا من كل بيت أن يقتصد ما وسعه الاقتصاد, وأن يَعُدَّ الأيام التي لا تزال الطيبة تعيشها الآن أيامًا رخية, وبعدها ستأتي المصائب الكبيرة كثيفة متلاحقة, فإنَّ الطيبة ظلت تعيش على أمل غامض, وظلت تنتظر شيئًا ما, لكن هذا الأمل لم يتحقق كما توهَّمه الكثيرون, وأصبح الانتظار طويلاً ممضًّا! والأبناء في المدن البعيدة لم ينتظروا صرخات الاستغاثة وإنَّما بادروا إلى تقديم كل ما يستطيعون. بعثوا بكميات من الحنطة والشعير, وبعثوا بالعدس والسكر والشاي والصابون, وبعثوا أيضًا يطلبون أن يأتي عدد من الأهل والأصدقاء, لينزلوا عندهم في المدينة. وأهل الطيبة, خصوصًا الذين تقدَّموا في العمر, لا يقوون على الاستجابة لمثل هذه الطلبات, ولا يتصورون أنفسهم يرحلون تاركين غيرهم للموت جوعًا وعطشًا. إن مجرد تصور شيء مثل هذا يولِّد في النفوس خجلاً لا يستطيعون احتماله, ولذلك لا يجيبون عن مثل هذه الرسائل, ولا يلبونها. والأبناء الذين رحلوا, وظلوا على صلة مع البلدة يعرفون جيدًا أن ما يطلبونه أقرب إلى المستحيل, ولن يستجيب إليه أحد, ولذلك بالغوا أول الأمر في إرسال كل ما يستطيعون, ثم بدأوا يتوافدون إلى البلدة, للزيارة أول الأمر, ثم للمشاركة بطريقة ما من أجل الوقوف في وجه هذا الكرب القاسي, لعلهم يستطيعون عمل شيء, أو أن يتعلموا شيئًا. كانت الزيارات تمتد أيامًا وتتكرّر في أوقات متقاربة, كما لا تقتصر على المشاركة الوجدانية أو الرغبة في تعذيب النفس, وإنما كانت ترافقها أشياء كثيرة: كميات إضافية من الحنطة والشعير, أثواب من الخام, وكانت تأتي معها الوعود والكلمات الكبيرة. وإذا كانت تلك الوعود أقسى الأشياء وأصعبها لكل إنسان في الطيبة, فقد أصبحت في هذه السنة عذابًا لا يطيق أحد أن يتحمله. (لم يبق إلاَّ القليل ويبدأ بعد ذلك بناء السد. والسد إذا قام لن تعطش الطيبة ولن تجوع. هكذا قال لنا الرجال المهمُّون في العاصمة), وقالوا أيضًا: (إنه قبل نهاية الخريف, وقبل موسم الأمطار, ستبدأ الآلات تشق التربة وتدفع أمامها الصخور, وسوف يأتي مئات العمال والمهندسين, وسترون ذلك بأعينكم!). وأهل الطيبة الذين يقبلون الأشياء التي تأتي ويوزعونها بعدالة مفرطة, كانوا يسمعون كلمات المدينة الكبيرة, ويسمعون عن السد الترابي الذي سينشأ قريبًا من الطيبة, ليجمع المياه التي تتدفق سيولاً جارفة في بعض المواسم, ثم تنتهي إلى باطن الأرض. ولا أحد يعرف كيف تغور هذه المياه أو إلى أين تذهب, ولا تبقي من تلك السيول غير تلك الكميات الكبيرة من الحصى والمجاري العميقة التي جرفت أجزاء من الأراضي والبساتين! ولا تبقي أيضًا سوى الكلمات الكبيرة والوعود! كان أهل الطيبة يسمعون ذلك بصمت حزين, ولا يدرون أيكذبون أبناءهم أو أولئك الرجال الرابضين هناك في الأبنية الكبيرة المغلقة? كانوا يقولون لأنفسهم: (لقد قيل لنا مثل هذا الكلام مرات كثيرة, وتنقضي السنوات, سنة وراء سنة, ولا شيء يتغير). وأهل الطيبة الذين تعوَّدوا نسيان السد والطريق والكهرباء في مواسم الخير, ولم يفكِّروا يومًا واحدًا أن يحصلوا على مثل هذه الخيرات, فإنَّهم في مواسم القحط يتذكرون كلّ شيء, يتذكرون هيئات الرجال الذين أتوا, والكلمات التي قالوها, ويتذكرون أن بعض الذين جاءوا زائرين مع أبناء لهم إلى الطيبة في سنوات سابقة, سنوات الخصب والمواسم الطيبة, وذهبوا إلى الصيد أيضًا في المناطق المحيطة بالبلدة, ورجعوا وقد امتلأوا بنشوة, وتصرفوا في لحظات معينة مثل الأطفال, وبدوا صادقين- إن بعض هؤلاء أصبح في المدينة البعيدة كبيرًا مهمًّا, بحيث لا يذكر اسمه إلاَّ كما تذكر أسماء الأنبياء والأولىاء. إن هؤلاء لم يعودوا يتذكَّرون الطيبة, ونسوا أصدقاءهم, وانتهى الأمر. والطيبة تعض على جراحها في مواسم القحط والجفاف. أما في مواسم الخير فلا تكف عن أن تبعث بسلال المشمش في بداية الموسم, ثم بسلال العنب والتين في نهايته, وبين الموسمين تبعث اللبن والجبن والبيض والخراف الصغيرة أيضًا, ولا تنتظر شيئًا من المدينة. تبعث الطيبة كل هذا برضا أقرب إلى الحبور. ويتصور الآباء والأمهات, وهم يبعثون بالسلال وأكياس اللبن في السيارة الصغيرة التي تذهب في الصباح الباكر, أنَّهم لا يقومون بواجب فقط, وإنما يحسّون بالمرارة والحزن إن تأخَّروا عن موعد سيارة الموظفين, أو إن لم يستطيعوا قطف التين في الوقت المناسب! والطيبة التي لم تتنكر ولم تتغير, وظلَّت وفية لكل شيء فيها ولكل إنسان عاش فيها أو مرَّ بها في يوم من الأيام, خلقت هذا الوفاء الفذ في أبنائها, والذي لا يوجد مثيل له فيما جاورها من القرى, ولا يوجد أيضًا في القرى البعيدة. في هذه السنة القاسية الملعونة جاء عدد كبير من أبناء الطيبة, جاءوا دون طلب ودون إيعاز من أي نوع, وما كادت أرجلهم تطأ أرض الطيبة, وعيونهم تلامس بيوتها, حتى أحسُّوا بالحزن العميق, ولاموا أنفسهم كثيرًا على أنَّهم تأخروا حتى هذا الوقت, وشعروا بتأنيب الضمير حتى قارنوا حياتهم في المدينة بحياة الناس في الطيبة. لكن هذا الحزن وهذا الندم تراجعا بسرعة ليحل مكانهما الرغبة القوية في أن يفعلوا شيئًا, لعلَّ الطيبة تنجو هذه المرة, ولعلها تحيا وتستمر إلى أن يُبنى السد, أو يقع شيء ما في المدينة البعيدة, ويصبح من الممكن بعد ذلك مواجهة الطبيعة القاسية دون انتظار للوعود الكاذبة أو للمطر الإبله الذي يأتي سنة وينقطع سنوات. يتبع،،،، |

|
|
|
#15 |
|
تميراوي
|
نزع الذين وصلوا لتوّهم ملابس المدينة, ولبسوا مثلما كانوا يفعلون حين كانوا في البلدة قبل سنوات. وخلال اليوم الأول مروا على أكثر بيوت الطيبة, وسألوا عن الرجال والنساء, وحزنوا كثيرًا على الذين ماتوا, وفكّروا في أمور واقتراحات كثيرة, وقرَّروا بينهم وبين أنفسهم عدة أمور, إن هم عادوا إلى المدينة مرة أخرى. لم يكتفوا بذلك, بل وزعوا ما جاءوا به, وكتبوا رسائل عديدة إلى أقرباء وأصدقاء في المدينة البعيدة وفي المهجر. وفي الليل سهروا طويلاً يفكّرون ويتكلمون, لكنهم كانوا يحسون في أعماقهم بالمرارة تكوي لهاتهم مع كل كلمة يقولونها, لأنَّهم لم يكونوا متأكدين من شيء! وإذا كانت الطيبة كثيرة الصبر والتسامح, وتغفر للغرباء مثلما تغفر لأبنائها, فإنَّها تعرف الغضب في مواسم الجفاف, وهذا الغضب الذي قد يأخذ شكلاً هينًا في بعض الأوقات يتحول في النهاية إلى جنون لا يطيقه ولا يتصوّره أحد. قال أحد القادمين, وكان شابًّا يدرس في مكان بعيد: - الناس هناك لا يفعلون كما تفعلون أنتم هنا, إنَّهم, هناك, يحوّلون الكلمات إلى قوة. قوة منظمة ومحاربة, ويجب أن نفعل مثلهم شيئًا عاجلاً قبل أن يلتهمنا الموت. قال رجل مسنّ, وهو يقلب شفتيه باستنكار, ويقلب نظراته بين الأرض والسماء: - وماذا تريدنا أن نفعل? وقبل أن يجيب الشاب تابع الرجل: - يجب أن تعرف, لا أحد يستطيع مقاومة الحكومة. علينا أن نكون عقلاء ونفكِّر فيما نستطيع عمله. قال الشاب بعصبية: - القحط إذا جاء تنامون سنةً كاملة, وإذا لم يجئ ترسلون الدعاء والرسائل ولا شيء غير ذلك, وبهذه الطريقة لن تبقي الطيبة! قال والد ذلك الشاب: - الطيبة, يا ولدي, باقية, لقد مرَّت سنوات صعبة كثيرة مثل هذه, تحمَّل الناس تلك السنوات وعاشوا بعد ذلك, وظلَّت الطيبة. ردَّ الشاب بسخرية: - الموت والحياة في مثل هذه الظروف متساويان. انظروا إلى الأرض والأشجار والدواب. وانظروا في وجوه البشر, إن كل شيء يموت, وإذا جاءت سنة مثل هذه السنة فلن يبقي شيء! كان يمكن لهذا الحديث أن يستمر وأن يتطوّر لكن حين دخل الضيوف, الذين جاءوا عصر ذلك اليوم, إلى المضافة, تغيَّر الجو فجأة. في عصر ذلك اليوم, في نهاية فصل الصيف تقريبًا, جاء أربعة من الضيوف, جاءوا مع أصدقاء لهم من أهل الطيبة, جاءوا في سيارتين, إحداهما سيارة جيب والأخرى فولكس فاكن صغيرة رمادية. وعلى الرغم من أن أبناء الطيبة, المقيمين والراحلين, يتميَّزون برهافة الحس ودماثة الخلق, ويعرفون كيف يعضُّون على جراحهم بصمت ويكتمون أحزانهم بصبر عجيب, حتى يخطئ الكثيرون في فهمهم أو تحديد مشاعرهم, فإنَّ الكثير من المتاعب والمشاكل التي يريدون بحثها والحديث فيها حين يخلون لأنفسهم, يتركونها جانبًا, ويتحدَّثون بطريقة مختلفة حين يأتي الضيوف. والمسنُّون الذين تعوَّدوا على كتم مشاعرهم وانتظار الأوقات المناسبة للحديث, يختلفون عن الرجال الأصغر سنّا, إذ يُصاب هؤلاء بنوع من الحمى ولا يقوون على كتم الأفكار والمشاعر التي تملأ صدورهم, خاصة في موسم مثل هذا الموسم. كانت هناك رغبة لأن يتحدث بعض الرجال للمرة الأخيرة, أمام الضيوف. وإذا كان الكثيرون من أهل الطيبة قد انتظروا بصبر فارغ مجيء الأبناء من المدينة, لكي يتحدّثوا للمرة الأخيرة, في أمر السد, متى يجب أن يقوم وماذا فعلوا من أجل قيامه, وأنهم لم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر مما فعلوا, وإذا صبروا وتحمَّلوا السنين الماضية بصمت فلن يستطيعوا بعد اليوم احتمال ذلك, وسوف يلجأون إلى وسائل جديدة لإقناع الكبار هناك في المدينة, بمدى القدرة التي يمتلكونها. إذا كان أهل الطيبة قد انتظروا طويلاً, فقد خاب ظنُّهم تمامًا حين رأوا عصر ذلك اليوم سيارتين غريبتين تدخلان الضيعة. أمَّا حين تعانق الآباء والأمهات مع أبنائهم العائدين, فقد طغت للحظات قوة الحب على قوة العتاب, وجاشت الدموع في العيون وغلبت جميع المشاعر الأخرى. ونتيجة ذلك تراجعت الأفكار والكلمات الغاضبة لتحل مكانها مشاعر المودة وكلمات الترحيب. والضيوف الذين لم يروا الطيبة قبل هذه المرة, لم يروا فيها شيئًا مختلفًا, ولم يحسوا بذلك الدوي الداخلي الذي يولّده الجفاف. أمَّا حين قابلتهم الابتسامات الواسعة والترحيب الحار فقد أحسُّوا بدفء داخلي وحسدوا هؤلاء الناس على هذا الرضا الذي يمتلكونه! بهذه الطريقة تأجَّلت أُمور كثيرة وحلَّت أخرى مكانها. فالأشياء التي حملها الأبناء من المدينة وُزِّعت بعناية, واختلى بعض المسنِّين لينصحوا بعضهم بعضًا أن يتصرفوا بحكمة, ولكي يطلبوا من الشباب احترام الضيوف مثلما تعوَّدوا دائمًا, دون إثارة لأي أحزان أو مشاكل. وقالوا في أنفسهم: (سيبقى الضيوف يومًا أو يومين ثم يرحلون, وبعد ذلك سوف نقلب الدنيا على رؤوس هؤلاء الأبناء العاقّين, الذين لا يعرفون شيئًا في الدنيا سوى إرسال بعض الحاجات في مواسم الجفاف, وكأن الطيبة أصبحت مأوى للمتسوّلين والجياع, ويجب أن تبقي كذلك). أما الوعود الكثيرة عن المياه التي ستتدفق طوال أيام السنة, أمَّا عن الأسماك التي ستزرع في البحيرة, عن القنوات التي ستمتد إلى مسافات بعيدة, فقد انتهى الأمر كله, ولم يبق إلاَّ صدى الكلمات يتردّد كل بضع سنين, شفقة أو حسرة على هذه البلدة التي تموت يومًا بعد يوم. هكذا كانت الساعات الأولى, وهكذا كانت مشاعر الناس, وأبناء الطيبة الذين أحسُّوا بغريزتهم أن كل شيء قد تغيَّر في البلدة, وأن الأيام التي يعيشها أهلها من القسوة إلى درجة لم يكونوا يتصورونها, ورأوا التغيُّرات العميقة التي دخلت في كل شيء يلمحونه. شعروا أنهم أذنبوا كثيرًا, وأن أي كلمات تقال الآن لا بدَّ أن تكون عاجزة ولا تعبِّر عمَّا تفيض به قلوبهم. ولأنَّ الضيوف قد أتوا, ولأنَّهم تعوَّدوا على شكل معين من التصرفات, فقد فهموا من النظرات, من الإشارات, وحتى من لمسات الأيدي, أن الطيبة تغلي ولا بدَّ أن تنفجر بشكل أو آخر, لكن هذه المشاعر تُركت جانبًا, لأنَّ الضيوف بدا لهم كل شيء غريبًا وطريفًا! أمَّا حين انعقد مجلس السمر فقد تركَّز الحديث على الصيد, لأنَّ الضيوف جاءوا لهذه الغاية. وما دام الضيوف يريدون هذا, فإنَّ هذا ما حصل! وأهل الطيبة الذين كانوا قادرين على التحدِّي والغضب في أوقات معينة, كانوا قادرين أيضًا على الصبر, ويلجأون إلى كل الوسائل لمواجهة الجوع والموت. وحين يُذكر الصيد وسيلة لمواجهة المجاعة, وإنقاذ ما يمكن إنقاذه, تتردّد كلمة واحدة, وكأنَّها كلمة السر: أين عساف? ودون عناء كبير يتبرع الكثيرون لمناداته, لإحضاره. وفي غمرة الحزن والجوع والتحدِّي ومواجهة الموت, ومن أجل التغلُّب على الحزن والجوع والموت, تفلت كلمة ساخرة, أقرب إلى الدعابة. يقول أحد الحاضرين, ليتغلب على المناقشة الحادة التي بدأت ولا يعرف كيف ستنتهي: - نريد عسافًا, احضروا عسافًا حيًّا أو ميتًا! دخل عساف عصبيّا مخطوف الوجه, وبغمغمة لا تكاد تُفهم, ألقى التحية, وجلس قريبًا من الباب. وأهل الطيبة الذين تعوَّدوا على عساف, وقبلوا جنونه, رفضوا بكثير من الإصرار أن يصطحب كلبه معه إلى سهراتهم وإلى مجالسهم. وهذا الرفض الذي آذي عسافًا كثيرًا, قابله برفض أشد قسوة وأشد إصرارا, حتى انتهى الأمر إلى ذلك الاتفاق الضمني بأن يدخل عساف إلى المجلس دون أن يصافح أحدًا, وأن يبقي كلبه قريبًا من الباب. وإذا كان عساف قد قَبِلَ هذه الشروط مكرهًا, فإنَّ علاقته بمجالس البلدة وأحاديثها قليلة إلى درجة أن الناس لا يرونه إلاَّ نادرًا. أما إذا جاء ضيف إلى البلدة من أجل الصيد, فقد كان أوّل الذين يجب دعوتهم وحضورهم هو عساف. وعساف الذي لا يحب حضور المجالس, يكره أيضًا هؤلاء الضيوف, ويًعُدُّهم, في أغلب الأحيان, ثقلاء شديدي البلادة والخور, لكن مثلما علّمته الطيبة, كان مضطرًّا إلى مصاحبتهم وإلى مجاملتهم, ومن أجل ذلك كان يتحمَّل الكثير! في هذه الأمسية, وحين أتوا بعساف, أحسَّ أن الأمر غير عادي. أمَّا حين جلس قرب الباب وأجلس كلبه إلى جانبه, فقد سمع أكثر من صوت يدعوه إلى صدر المجلس, وإزاء رفضه, نهض واحد من أبناء الطيبة القادمين مع الضيوف, ومدَّ يده يحيِّي عسافًا بحرارة أول الأمر, ثم يسحبه بقوة لكي يغيِّر مكانه. استمر الأمر بعض الوقت, بين القبول والرفض, إلى أن اقترح أحد المسنِّين انتقال عساف وبقاء الكلب حيث كان. إن في حياة كل إنسان لحظات من الخصوبة لا يدركها, ولا يعرف متى أو كيف تأتيه أو كيف تنفجر في داخله. إنَّها تندفع فجأة, تعربد مثل الرياح أو مثل الأمطار الغزيرة المفاجئة, وتطغى على كل شيء, ومثلما تأتي فجأة تنتهي كذلك, وكأنَّها مياه غارت لتوّها في أرضٍ رملية عطشى! هذه اللحظات لا يخطط لها أحد ولا يدبرها أحد, حتى لو أراد. وعساف الذي جاء مكرهًا, ليلتقي ببعض الوجوه التي لم يرها من قبل, وقد لا يراها مرة أخرى بعد أن تغادر الطيبة, والذي أغضبته كلمة أحد المسنِّين حين طلب منه أن يُبقي كلبه عند وصيد الباب, وجد نفسه فجأة في عالم من الوجد وأقرب ما يكون إلى التجلِّي, إذ ما كاد يُسأل عن الصيد, وعن عدد الطيور التي صادها ذلك اليوم, وكيف كان الموسم بصورة عامة, حتى أحسَّ بالاختناق, وتمنَّى لو أنه لم يأتِ, وتمنَّى أكثر من ذلك لو يستطيع مغادرة المجلس. لكنه كان يعرف أهل الطيبة, يعرف مقدار الود القاسي الذي يكنُّونه له, ويحس أن رابطة عمرها مئات السنين تربطه بكل ما حوله من أرض وبشر وأشجار ومياه, وأن هذه الرابطة تكون أشد وأقوى حين تمر سنة صعبة مثل هذه السنة التي تمر على الطيبة. كان مصممًا, أول الأمر, ألاّ يتكلم, فإذا حاصروه بالأسئلة, ولم يجد مجالاً للهرب, فلا أقل من بضع كلمات يقولها, لكن فجأة امتلأ بشعور الألفة والتحدِّي معًا, وأحسَّ أن قلبه يخفق بضربات سريعة أكثر مما تعوّد حين يكون في مثل هذا الموقف, وقرَّر أن يفعل شيئًا لم يفعله من قبل. يتذكّر هو نفسه, ويتذكّر كل مَن كان موجودًا, أنه لأول مرة في حياته, قرَّر أن يخوض معركة لم يخض مثلها من قبل, رغم ما يُقال دائمًا من أن حياته منذ بدأت معركة متصلة, إذ ما كادت الأسئلة تنهال عليه, وكلها عن الصيد, حتى صرخ بتحدِّ: - تعال... تعال يا حصان! وانتفض الكلب فجأة, ومثل حية ملساء, انسل ليجلس عند أقدام عساف. كانت الحركة مفاجأة, لم يتوقعها أحد, وللحظات خيَّمت الدهشة وعمَّ الذهول. والمسنّون الذين يملكون, أغلب الأحيان, الحق بالأمر والنهي, أحسُّوا أن صوت عساف, وهو يدعو كلبه, غير مألوف, ولا يمكن مقاومته. تبادلوا النظرات فيما بينهم, ونظروا إلى عساف, لكن لأول مرة في حياتهم الطويلة الحافلة يكتشفون في عينيه بريقًا قاسيًا وحشيًّا, ودون وعي أو إرادة, تراجعت كلمات الاعتراض لتحل مكانها هزات الرؤوس تعبيرًا عن الأسف وشيء من العتاب. لم ينتظر عساف, اعتدل في جلسته, أجال نظرة طويلة في وجوه الناس الذين خيَّم عليهم الصمت, وبطريقة مليئة بالمحبة والحنان معًا, امتدَّت يده إلى الكلب, مسَّد على ظهره أكثر من مرة, ودون أن ينظر إلى أحد, وكأنَّه يخاطب نفسه, بدأ: - ماذا تظنُّون يأهل الطيبة? هل تظنّون أن هذه السنة مثل السنين القاسية التي مرَّت عليكم? هل تظنون أنَّكم ستواصلون الحياة حتى تأتي الأمطار مرة أخرى? إن مَن يظن ذلك أقرب إلى الجنون. توقف لحظة. عبَّ نفسًا عميقًا من سيجارته, وتطلع في وجوه الرجال مرة أخرى, ثم تابع: - قلت لكم ألف مرة: لم يبقَ بيننا وبين الموت إلاَّ ذراع, وهذه الذراع هي الصيد الذي نستطيع أن نوفره حين تأتي الأمطار مرة أخرى. قلت لكم مئات المرات وأنتم لا تسمعون هذا الكلام, وبدل ذلك تزدادون حماقة يومًا بعد يوم. قلت لكم: اتركوا إناث الحجل للسنوات القادمة, إنها رزقنا الباقي. قلت لكم: وفّروا الخرطوش ولا تُفزعوا الطير, وعندها سيأتي إليكم بدل أن تذهبوا إليه, لكنكم يومًا بعد آخر تزدادون عنادًا وتحدّيًا. قلت لكم: انقلوا من النبع حِمْل حمارين أو ثلاثة حمير وارموا بها في الخوابي القريبة, ثم اربضوا هناك حتى تأتي الطيور, فامتلأت وجوهكم بالابتسامات الساخرة, وقلتم: عساف انهبل, لأنه يطلب منا أن نبذر ما تبقَّى لنا من الماء ونرميه في الصحراء. والآن تأتون بهؤلاء الأفندية وتتظاهرون بالنبل والكرم وتطلبون من عساف أن يصطحبهم إلى الصيد, وأن يجعلهم يصيدون! ماذا يستطيع أن يصيد هؤلاء أو غيرهم ما دمتم ملأتم الدنيا بالطلقات المجنونة تبذرونها في الهواء, حتى لم يبق طير من طيور السماء أو حيوان من حيوانات الأرض إلاَّ وسمع عددًا لا حصر له من الطلقات? وحرَّك يديه بطريقة يائسة, وتطلّع في وجوه الضيوف, ثم تابع بلهجة جديدة: - يا سادة, كان الحجل يصل إلى أبواب البيوت. كانت الغزلان والأرانب تملأ السهل كله. كانت ممرات الترغل كثيرة إلى درجة أن عسافًا نفسه يحتار إلى أين يذهب وأي الممرات يفضّل. هكذا كان الأمر في الأوقات السابقة, وأهل الطيبة بدل أن يحافظوا على هذه النعمة, لم يتركوا أي ابن عاهرة ولمسافة ألف كيلو إلاَّ ودلُّوه على الطيبة. اعذروني, أنا لا أقصد أي واحد منكم, أنتم على عيوننا وعلى رؤوسنا, لكني أقصد الصيادين الآخرين الذين يأتون من كل مكان, وكأن ليس في الدنيا سوى الطيبة, وهؤلاء الذين يأتون لا يعرفون سوى شيء واحد: القتل. كانوا يقتلون كل ما تقع عليه أعينهم. كانوا يقتلون إناث الحجل قبل ذكورها, لأن الذكور وهي تجفل وتطير من الخوف, كانت تخلّف في قلوب هؤلاء الصيادين خوفًا كبيرًا, وبعد أن يستعيدوا شجاعتهم تطير الإناث فيضربونها. والشيء نفسه يفعلونه بالغزلان والأرانب وكل الحيوانات الأخرى, وحين يعودون محملين بالصيد الكثير لا يكتفون بأن يعودوا إلى هنا مرة أخرى. إنهم يدلّون أصدقاءهم وأصدقاء أصدقائهم, إلى عاشر جدّ, ويحضرون معهم أنواعًا من السلاح لا يتصورها عقل ولا يقاومها صخر. وبهذه الطريقة, وسنة بعد أخرى, أقفرت الطيبة. والآن تريدون من عساف أن يستولد لكم الطيور والحيوانات ولا أعرف أي عفاريت أخرى? ماذا يستطيع عساف أن يفعل? هل هو مسيح جديد? هل هو الذي يبيض ويفقس?). ومن جديد امتدَّت يده لتستقرَّ على ظهر الكلب, وينظر إلى الوجوه التي اعترتها الدهشة وخيَّم عليها الصمت: - لم يخلق الصيد للأغنياء أو الذين يقتلهم الزهق والشبع. لقد خلق للفقراء, وللذين لا يملكون خبز يومهم. وعساف الذي قضى حياته كلها في البرية لا يصيد في مواسم الخير إلاَّ ما يملأ معدته ومعدة هذا الحيوان. أمَّا في مواسم الجفاف, ولكي لا يموت الناس في الشوارع, فيمكن أن يكون الصيد حلاً, كما هو الحال ونحن نستبدل بخبز القمح خبز الشعير, لكن لا أحد يفهم في الطيبة وفي غيرها من المدن والقرى. إن الإنسان في هذه الأيام يمتلك روحًا شريرة لا تمتلكها الذئاب أو أي حيوانات أخرى, ولهذا السبب نواجه اليوم الجوع, وسيكون الجوع غدًا أشد وأصعب. إنَّني أرى ذلك كما أراكم الآن. وإنَّني أخاف من الغد أكثر مما أخاف اليوم الذي أعيش فيه. هذا ما صنعناه بأيدينا! يتبع،،،، |

|
|
|
#16 |
|
تميراوي فضي
|
اشكرك اخوي
وجزاك الله كل خير 00 |
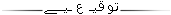

|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 |
 |
 |